عدنان كنفاني
لماذا نفتح الآن صفحات رواية أم سعد التي صدرت في العام 1969.. وبعد هزيمة حرب حزيران 1967 عن كاتبها الأديب الفلسطيني الشهيد غسّان كنفاني..؟
ولماذا نحاول الغوص في أحداث وتفاصيل صغيرة وكبيرة مضت وانقضت.؟
أزعم أن الأحداث الساخنة التي مرّت وتمرّ فيها القضيّة الفلسطينية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن تحرّضنا ونحن نعيد قراءة أم سعد مرّة بعد مرّة لندرك عمق نظرة غسّان الاستشرافية التي استطاع من خلال كتابته لتلك الرواية بالذات وفي تلك المرحلة الرديئة أن يؤشر إلى دلالات كثيرة كانت ضرورية في حينه، وما زالت تحتاجها ساحات نضالنا.. وفي الوقت نفسه أجابت على أسئلة كثيرة لم تبرز في ذلك الوقت فقط، بل ما زالت تبرز وتُطرح علينا وعلى وسائل نضالنا وطرائقه حتى الآن..
أزعم أيضاً أن رواية أم سعد كانت ضرورية في تلك المرحلة تحديداً وقد عانت قضية فلسطين وشعبها الفلسطيني وفصائلها الوليدة بعد حرب حزيران وفي الجو الانهزامي العام الذي ألقى ظلاله القاتمة على الأمّة كما عانى العرب في أمصارهم من شعور قاسٍ بالهزيمة، ومن حالة إحباط رسمية وشعبية أوحت للعالم أن الأمة العربية كلها سقطت ولن تقوم لها بعد الآن قائمة..
من ذلك القاع المظلم قام غسّان وأقام أم سعد.. أم الشعب وأم الأرض، وأم التاريخ.. قامت وهي ضمير فلسطين تنتزع من قلب اليأس قصفة دالية، وتشرعها رغم يباسها الآني، وتعلن بلحمها ودمها وشموخها وصلابتها بأننا ما زلنا هنا باقون كالجبال، وأنها هي القادرة على العطاء كما لا يقدر أحد.. ولا تقول ذلك شعارات جوفاء فارغة، بل فعل حقيقي بدأت فيه بنفسها وفلذات كبدها، وأرسلت تلك الرسالة التي حملت الراية التي نراها الآن تخفق على بطاح فلسطين.. ونقلت سكنها من خيمة كسيرة ذليلة إلى خيمة أخرى تصنع فيها الرجال والقرار، وأخرجت ذلك الفلسطيني الفتيّ المهزّم المحبوس من سجونه كلّها وأطلقته في الفضاءات..
نبحث عنها في زواريب المخيّمات فنراها في وجوه كل النساء الفلسطينيات.. حتى سعد ورفاقه أبناء الجيل الفلسطيني المقاتل، يرونها كذلك في أحلك اللحظات:
كانوا قد حوصروا، إلا أنهم احتفظوا بمكمنهم هادئين، وقدّروا أن الحصار سينفكّ بعد ساعات.. امتدّ الحصار أياماً حتى أنهكهم الجوع… عند الظهر قال سعد لرفاقه:
- ها قد جاءت أمي..
وبدت لهم عجوزاً في عمر أم سعد وفي قامتها العالية الصلبة.. قال أحد الأربعة:
- أمّك..؟ أمّك في المخيم يا أخوت..
قال سعد:
- أنتم لا تعرفون أمي ،إنها تلحق بي دائماً، وهذه أمي..
وفجأة ناداها:
- يمّا.. يمّا..
توقّفت المرأة لحظة، وأدارت بصرها في الحقول الصامتة حولها:
- أنا هون يمّا.. أنا سعد يا يمّا، جوعان..
سقط القضيب من يد الفلاّحة العجوز وهي تحدّق إلى الشاب الذي ولده الدغل الشائك ينحدر نحوها بالكاكي، وبالرشّاش على كتفه:
- يجوع عدوّيك يا ابني.. تعال لعند إمّك..
تلك المرأة العجوز ظلّت خمسة أيام تطعمهم لم تتأخر ساعة واحدة حتى انفكّ الحصار.. جاءت فوضعت الزوّادة ونادت:
- العسكر راحوا.. الله يوفّقكم..
حكاية سردتها أم سعد على مسامع الراوي..غسّان. الذي لم يستطع إلا أن يؤكّد لنا على لسانه هذه المرّة دون لبس عظمة الرمز الفلسطيني الذي تمثّله أم سعد.. فبعد أن انتهت من سرد قصّتها: استدارت.. خطوة.. خطوتين..
وفجأة سمعت نفسي أناديها:
- يمّا.. يمّا..
أم سعد.. "أم حسين" الشعب المدرسة.. المرأة الحقيقية التي يعرفها غسّان –وأعرفها- جيداً.. امرأة مسحوقة فقيرة مرميّة في مخيّمات البؤس، ومربوطة إلى تلك الطبقة الباسلة.. تعلّم منها غسّان الكثير، واقتنص من شفتيها الفلسطينيتين، ومن كفيّها الصلبتين كل حرف جاء في سطور الرواية التي تحمل اسمها.. صوتها هو صوت تلك الطبقة الفلسطينية التي دفعت غالياً ثمن الهزيمة، ومع ذلك فأم سعد ليست امرأة وحدها، عندما تطل من الطريق المحاط بأشجار الزيتون تبدو كشيء انبثق من رحم الأرض بقامتها العالية كرمح يحمله قدر خفيّ.. تصعد من قلب الأرض وكأنها ترتقي سلّماً لا نهاية له، وتسير عالية كما لو أنها علم ما تحمله زنود لا ترى..
سيّدة في الأربعين، قويّة كما لا يستطيع الصخر، صبورة كما لا يطيق الصبر، تعيش عمرها عشر مرّات في التعب والعمل كي تنتزع لقمتها النظيفة، ولقم أولادها.. صدرها مليء بحطام العذاب والأسى.. راحتاها تشبهان جلد أرض يعذّبها العطش، وجبينها يحمل لون التراب.. نظراتها في لحظات النبوءة وتصويب الحقيقة تسدّد رمحاً بسرعة الرصاصة ، كلماتها مشدودة كأنها قصف له رائحة مقاومة باسلة..
جاءت مثلما تتفجّر الأرض بالنبع المنتظر منذ أول الأبد، مثلما يستّل السيف من غمده الصامت، ووقفت هناك، على بعد لحظة واحدة من بريق العين الصامدة.. عمري كله لم أرَ كيف يبكي الإنسان مثلما بكت أم سعد، تفجّر البكاء من مسام جلدها كله، أخذت كفّاها اليابستان تنشجان بصوت مسموع، كان شعرها يقطر دموعاً.. شفتاها، عنقها، مزق ثوبها المنهك، جبهتها العالية، وتلك الشامة المعلّقة على ذقنها كالراية.. ولكن ليس عينيها..!
أم سعد الواقفة تحت سقف البؤس الواطئ في الصف العالي من المعركة، تدفع، وتظلّ تدفع أكثر من الجميع..
هكذا قدّم غسّان أم سعد لنا..
فهل أستطيع أن أصدّق أن امرأة واحدة في هذا الكون تحمل هذا الفيض من الصفات.؟ ألف مرّة ألحّ عليّ السؤال.. قرأت التاريخ، وتسقطت أخبار الناس من ذواكر الناس، وفردت في لحظات سحريّة ذاكرتي التي ما زالت ترى وتسمع وتعيش الحدث وراء الحدث، فجاءني الجواب..!
هي قبيلة نساء، كل النساء المشدودات بأثوابهن المزركشات، وزغاريدهن المصّفقات وراء نعوش فلذات أكبادهن.. هي الأرض تعطي وتحتضن ولا تتعب، هي الرمز الفلسطيني المستمرّ عند اشتداد النوائب، هي القادرة وحدها على الإجابة على الأسئلة الصعبة.. هكذا رآها غسّان وهكذا فرد صورتها أمامنا، وأسال على لسانها كل الإرادات المتزاحمة في رأسه وخيالاته..
امرأة خرجت مع من خرج من قريتها الغبسية في فلسطين في العام 1948وأطبقت عليها وعلى جيلها زواريب مخيم، حاصرتها رجفات الطين.. وحفرت المسامير الفولاذية في كفيّها أعمق الأخاديد:
جاءت الطائرة، مطليّة باللون الأسود، وحلّقت على علوّ خفيض، وأخذت تزخّ رصاصها على الشارع، وسمعت أم سعد صوتاً معدنياً كالرنين يملأ الطريق، وفي اللحظة التالية تقدّمت نحو الإسفلت، ورفعت بين أصابعها قطعة حديد ذات أربعة رؤوس مسننّة.. قالت لرفيقاتها:
- هذه الحدائد تفرقع دواليب السيّارات.!
ودوّرتها بين أصابعها، ثم قالت:
- يا صبايا لنلمّها ونقذف بها إلى الرمل..
اندفعت النساء ومن ثم اندفع الأولاد وسرعان ما انتشروا جميعاً كالأشباح على طول الطريق ينظّفونه من العراقيل..
مقاتلة أيضاً بيديها وأسنانها إذا دعت الحاجة.. أليست هذه هي المرأة الفلسطينية التي نراها الآن وفي كل وقت وقد استطاعت بصمت ردم فجوة السؤالات التافهة المصطنعة عن المعنى الحقيقي للحب والحنان والأمومة ثم المساواة.؟ أزعم أن غسّان جعلنا ندرك وبصمت أيضاً قدرتها على التفوّق..
شقّت غرفة بيتها الوحيدة الطينية صفيحة تنك قسمتها إلى شطرين بائسين، ودفعها جوع الصغار للبحث عن وسيلة عيش نظيفة لم تجدها إلا في آهات التعب، وفي خدمة بيوت الأغنياء في المدينة الصاخبة، قويّة صلبة شامخة.. حتى في بحثها عن لقمة العيش تلك:
- يعطيك العافية
- الله يعافيكي يختي
وانتصبت أم سعد بقامتها العالية، شادةً ظهرها إلى الوراء.. كانت المرأة الواقفة هناك تبدو ريفية:
- خير.؟
وقالت المرأة:
- جئت إليك لأقول شيئاً.. أنا التي كنت أنظّف هذا الدرج ثلاث مرات في الجمعة، وقبل شهر وثلاثة أيام جاء الخواجا وقال لي مع السلامة.. كم يعطونك.؟
- خمس ليرات يختي.
- كانوا يعطونني سبع ليرات.. أنا امرأة عندي أربعة أولاد، وقالوا سبع ليرات كثير..
- وجعلوني أنا أقطع رزقك.. الله يقطع رزقهم.. منين الأخت بلا صغرة.؟
- أنا من الجنوب.
- فلسطينية
- لأ.. لبنانية من الجنوب..
مسحت أم سعد راحتيها المبتلّتين بردائها، ثم أخذت تنزل كميّها المشمّرين وتنظر حولها ثم قالت:
- يختي والله لم أكن أعرف، ولم يقولوا لي.. خذي اشطفي بقيّة الدرج.. الله يقطع هالبناية وصحابها..
كان الدرج مبتلاً، وهسيس الماء وهو ينحدر درجة وراء أخرى يصعد إلى سمعيهما كهدير غامض لنهر عميق، ودون أن تلتفت أخذت أم سعد تنزل الدرج.. وحين وصلت إلى المدخل وقفت هنيهة تصيخ السمع حتى سمعت صوت الماء يتدفّق من جديد.. عندها فقط تنفّست بعمق..
بقي أن نعلم أن الخواجا صاحب البناية استعمل الناطور المسحوق أيضاً لإتمام تلك الصفقة، والدفع بواحدة لقطع رزق الأخرى.. ولأنها أم سعد، ولأن غسّان هو الراوي فقد أصرّا على أن تكون النهاية، رسالة أخرى لا تغيب عن فطنة المتلقّين:
وصرنا عند ذاك على الطريق العام، فوقفنا ننتظر السيارة التي تقلّ أم سعد إلى المخيم وهناك خطر لها خاطر:
- لو أنا والناطور والحرمة قلنا للخواجا…..
امرأة يفوح عبق الريف الفلسطيني من ثوبها ومن شالها الأبيض وصرّتها الفقيرة، إذا تكلّمت فالحكمة المستقاة من تجارب وجع الحياة، في جملها القصيرة المقتضبة البسيطة تضع إصبعها على صميم الوجع، وفي خواتيم كلماتها تقتلع الحلول من أفئدة المرجفين.. وعبر كلمات عابرة تشرّح المأساة برمّتها.. فطرتها الحب الذي لا يفتر، ورغباتها لا تتعثر بل تصير على حجم عطاء الحياة، وأملها حيّ لا تدفنه المآسي ولا زفرات الموت..
عندما تصدّعت عزائم الرجال إثر هزيمة حزيران 1967 حملت عوداً يابساً قطعته من دالية صادفتها في الطريق، وغرسته في التراب:
- قضيب ناشف
- إنه يبدو كذلك، ولكنّه دالية.. قد لا تعرف شيئاً عن الدالية، شجرة معطاءة لا تحتاج إلى كثير من الماء، أنا أقول لك، إنها تأخذ ماءها من رطوبة التراب ورطوبة الهواء، ثم تعطي دون حساب..
هكذا فهمت الحياة.. لأنها أدركت أن عليها أن تكون الأرض.. وعليها أن تعبّد من جديد إرادة النصر، وهي تعلم أن حرب حزيران:
- بدأت بالراديو، وانتهت بالراديو.. وحين انتهت قمت لأكسره، ولكن أبا سعد سحبه من تحت يدي.. آه يا ابن العم.. آه..
أي وجع يختار طريقه إلى لبّ العظام.. فهل تستسلم القامات الفارهات.؟:
- الزيتون لا يحتاج إلى ماء أيضاً، إنه يمتصّ ماءه عميقاً في بطن الأرض..
مثلها.. هي المطحونة، المحاصرة، التي لا تستطيع أن تفرح بمشاركة ابنها في حرب خسرناها قبل أن تبدأ، وهي ترى في سعد -المسحوق أيضاً، الممنوع حتى من حريّة التنفّس- ذلك الجيل الفلسطيني الجديد الذي تربّى في مستنقعات البؤس ورضع المأساة لكنّه لم يستطع أن يهضمها:
- لقد ذهب سعد، ولكنّهم امسكوه، ومنذ يومين كنت أعتقد أنه يحارب. هذا الصباح عرفت أنه كان محبوساً.. يا للعار.. كنت أقول لنفسي: لو مات…..
لكنّه خرج من السجن ولم يوقّع على ورقة يتعهد فيها أن يكون آدمي، لأنه رضع من ثدي أم سعد فهو يفهم "الآدمية" شكلاً مغايراً لما يريد من حبسوه:
- يا حبيبي أوادم يعني بنحارب، هيك يعني هيك..!
ولم يلبث أن التحق بالفدائيين في الأغوار.. وحتى تكتمل الصورة التي أرادها غسّان فإنه يعيدنا إلى المخيم، وإلى أبي سعد الذي لم يأت على ذكره إلا في الفصل الختامي للرواية، ويصفه:
كان يأتي دائماً منهكاً، ويطلب طعامه بسؤال فظ، ويكاد ينام وهو يعلك لقمته الأخيرة.. وحين كان يتعطّل عن العمل كان يزداد فظاظة، ويأخذ في الذهاب إلى القهوة وينهر على كل الناس.. وإذ يعود إلى البيت كان لا يطاق، وكان ينام واضعاً كفيّه الكبيرتين الخشنتين اللتين تملؤهما آثار الإسمنت والتراب تحت رأسه، ويأخذ بالشخير عالياً، وفي الصباح يشاجر خياله…
الآن تغيّر كل شيء فجأة، عندما يشرع بالحديث مع أي رجل عابر، يتحدث عن "الكلاشنكوف" ويفضّل أن يشير إليه بمجرد كلمة "كلاشين" مثلما يفعل سعد حين كان يزورهم..
لقد ذهب في تلك الظهيرة إلى حيث كان مكبّر الصوت يعلو بحديث لم يكن يسمع مثله من قبل، ووقف هناك فوق الجدار يرقب مثلما المصاب بالذهول أطفال المخيم وبناته ورجاله يقفزون عبر النار ويزحفون تحت الأسلاك ويلوحون بأسلحتهم، وقد شهد "سعيد" ابنه الأصغر يقدّم أمام حشود الناس عرضاً عمّا يتعين على المقاتل أن يفعل حين يتعرّض لطعنة حربة كي يتجنّب الأذى..
وصلت أم سعد فوقفت إلى جانب زوجها على سطح واطئ، وأخذت تطلّ نحو الساحة، وحين ميّزت "سعيد" هناك أطلقت زغرودة طويلة تجاوبت بزغاريد نبعت على طول المكان وعرضه..
فجأة التفت رجل عجوز كان يجلس على حافّة الجدار إلى أبي سعد وقال له:
- لو هيك من الأول، ما كان صارلنا شي
ردّ أبو سعد:
- يا ريت من الأول هيك..
وأشار بذراعه الممدودة إلى وسط الساحة وقال له:
- ترى ذلك الولد الذي يرفع المرتينة.؟ إنه ابني سعيد.. وأخوه سعد مع الفدائيين في الأغوار..
شدّ أبو سعد زوجته نحوه وأشار لها قائلاً للرجل العجوز الذي كان ما يزال ينظر إلى الساحة:
- هذه المرأة تلد الأولاد فيصيروا فدائيين.. هي تخلّف وفلسطين تأخذ..!
مرّة أخرى يقول غسّان إن الكفاح المسلّح وحده محمولاً على إرادة حقيقية هو القادر على استعادة الحق.. ومرّة أخرى يقدّم لنا أم سعد بقامتها العالية نبعاً للمعرفة، وضميراً للأرض.. المرأة الفلسطينية التي لا بد ترى صورتها مطابقة لصور كل النساء الفلسطينيات…
وفوّحت الغرفة برائحة الريف العريق حين أخذت أم سعد صرّتها الصغيرة وتوجّهت إلى الباب.. ولوهلة اعتقدت أنها مضت.. إلا أنني سمعت صوتها يعبر من بين المصراعين المفتوحين على وسعهما:
ـ برعمت الدالية يا ابن العم.. برعمت..!

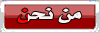




» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918