جواد البشيتي
6.2 مليون نسمة عدد سكَّان الأردن؛ أمَّا عدد "سكَّان"، أي أعضاء، الأحزاب السياسية الأردنية فلا يزيد عن 10 آلاف "نسمة"، أي عضو، يتركَّزون في 18 حزباً مُرخَّصاً لها؛ وكلُّ حزب ينبغي له، قبل، ومن أجل، أن تُرخَّص له وزارة الداخلية في مزاولة العمل السياسي أن يَضُمَّ في صفوفه ما لا يقل عن 500 عضو مؤسِّس.
الأردنيون، عموماً، هم شعب "مُسيَّس"؛ بل هم من طائفة الشعوب الأكثر اهتماماً بالسياسة، فنادِراً ما تَجِد أردنياً لا يتحدَّث في السياسة، أو لا يدلي برأيه في الشؤون والقضايا السياسية المختلفة، أو لا يَنْفَعِل سياسياً، أو لا يُنْفِق جزءاً كبيراً من وقته اليومي في متابعة الأحداث والتطوُّرات السياسية عَبْر نشرات الأخبار والبرامج السياسية التي تبثها القنوات الفضائية (السياسية في المقام الأوَّل) كقناة "الجزيرة".
إنَّها ظواهر أردنية كالأحاجي، فلو جاءكَ أحدهم وقال لكَ إنَّ هناك مجتمعاً يزيد عدد أفراده عن ستَّة ملايين، منهم عشرة آلاف شخص فحسب ينتسبون إلى أحزاب سياسية (مُرخَّص وغير مُرخَّص لها) لاسْتَنْتَجتَ أنَّ هذا المجتمع لا يَعْرِف شيئاً يُعْتَدُّ به من الحياة الديمقراطية، ومن الحياة السياسية، ومن الاهتمام بالسياسة؛ أمَّا لو قال لكَ إنَّ هناكَ مجتمعاً تُهَيْمِن السياسة على معظم أفراده، تفكيراً وكلاماًَ ومشاعر، ويُسْمَح فيه، في الوقت نفسه، بحياةٍ حزبية، لاسْتَنْتَجتَ أنَّ مئات الآلاف من أفراده ينتسبون إلى الأحزاب السياسية.
الشعب الأردني، والحقُّ يقال، شعب "سياسي"؛ ولكن في معنى مخصوص، فهو شعب ذكي سياسياً، ومثقَّف سياسياً، يعي جيِّداً بواطن وخفايا الأمور السياسية، يرى دائماً الأكمة وما وراءها، وإنْ حَمَلَتْهُ ظروف عيشه، التي يشقُّ على الديمقراطية العيش فيها، على أن يُوْكِل أمْر تمثيله البرلماني إلى أناسٍ لا يملكون ما يملكه المواطِن العادي من الأهلية السياسية.
ولو أرَدْنا التحدُّث عن الشعب الأردني، لجهة صلته بالسياسة، في لغة فلسفية، لقُلْنا إنَّه ينتمي إلى تلك الفلسفة التي تقتصر مهمتها على "تفسير العالم"، فالأردني مؤمِنٌ ومُقْتَنِعٌ بأهمية وضرورة وجدوى فهم ومعرفة وتفسير عالمه السياسي الواقعي؛ ولكنَّه غير مؤمِن، وغير مُقْتَنِع، بأهمية وضرورة وجدوى أن يسعى إلى "التغيير"، وأن يكون جزءاً من أداته، ومن أداته الحزبية على وجه الخصوص، فتجربة العمل الحزبي أقْنَعَتْهُ بأنَّ الأحزاب السياسية التي عرفها واختبرها ليست بأداة صالحة للتغيير الذي يحتاج إليه، ويريده، وبأنَّها لو كانت صالحة، أو يمكن أن تصبح صالحة، لما استطاعت إلى التغيير سبيلاً؛ لأنَّها تعيش في "بيئة سياسية" غير ملائمة لتغييرٍ كذاك.
من قبل، أي حتى العاشر من نيسان 2007، عَرَفَ الأردن كثرة في الأحزاب السياسية، أي في "دكاكين" تسمَّى "أحزاباً"، فالحزب كان ممكناً أن يُوْلَد ولادة قانونية بخمسين عضواً مؤسِّساً فحسب، فاخترع "المُصْلِحون"، أو "الإصلاحيون"، نظرية للإصلاح السياسي قوامها أنْ لا سبيل إلى الإصلاح السياسي قبل "الاختصار" و"التركيز"، فكثرة الأحزاب، أو وجود أكثر من ثلاثة أحزاب "ثقيلة الوزن الشعبي والسياسي"، يتسبَّب بـ "زحامٍ"، يتسبَّب بـ "عرقلة السير"، فكيف لعربة الإصلاح السياسي أن تتقدَّم في سيرها في مسارٍ يشتد فيه الزحام؟!
الرقم 3
"الأرقام" هي ضَرْبٌ من "التجريد الخالص"، فالمرء ليس في مقدوره الذهني أن يفضِّل رقما على رقم، أو أن ينحاز إلى رقم ضد رقم، إلاَّ إذا قام أوَّلا بكسو هذا "العَظْم الرياضي" لحما، أي حوَّل الرقم من "المجرَّد" إلى "الملموس".
ومع ذلك، يظل الرقم 3 أشهر الأرقام جميعاً؛ ففي القرآن، تتضمَّن "البسملة" الله والرحمان والرحيم، وفي الإنجيل، يتضمَّن ما يشبه "البسملة" الآب والابن والروح القدس؛ وفي الفلسفة، نقف على "الثلاثية الهيجلية" الشهيرة، والتي ظهرت في الدياليكتيك المادي لماركس وإنجلز على هيئة قانون من أهم القوانين العامة للتطور في الطبيعة والتاريخ والمجتمع والفكر؛ أمَّا في الأردن، فالرقم 3 هو المفضَّل لحياة حزبية؛ والأردنيون ينتظرون الأحزاب الثلاثة الكبيرة كمن ينتظر سقوط السماء على الأرض. حتى الشر يبلغ منتهاه بالرقم 3، فنقول: "رماه بثالثة الأثافي".
إنَّنا جميعا "نتمنى" الحياة الحزبية، فـ "الموات الحزبي" هو، حتى الآن، جوهر الحياة السياسية لمجتمعنا، الذي في الليل يتكلَّم عن الأحزاب السياسية، وعن ضرورتها وأهميتها والحاجة إليها، فإذا النهار طلع وتجلَّى مُحيَ كلام الليل، وعُدْنا إلى الاستمساك بكل انتماء منافٍ لحياة حزبية حقَّاً، فما نَيْل "الأحزاب" بالتمني!
وكل ما قُمنا به حتى الآن، أي منذ زمن سياسي طويل، من أجل التأسيس لحياة حزبية لم يتمخَّض إلا عمَّا يقيم الدليل على أنَّ "عَمَلَنا" كان، وظلَّ، "كلاما"، وكأنَّنا لا نَعْرِف إلا ما يشبه "الصلاة" طريقا إلى "الخلاص الحزبي"، فتارةً ننحو على مجتمعنا العاقِر (حزبيا) باللوم، وطورا ننحو على "الأحزاب" ذاتها باللوم، فهي وفيرة، كثيرة، متكاثرة، يَزْدِحم بها "شارعنا السياسي"، فَتَقِلُّ "الحركة"، التي هي "سكون" لا يَظْهَر إلا لنا على أنَّه "حركة".. وهي تأبى "التعدُّدية الحزبية الرشيدة"، تتصارع تَصارُع الديكة (من غير أن تبيض ولو "بيضة الديك") أمام جمهور لو نَطَق لخاطبهم قائلا "إلام الخلف بينكم إلام وهذه الضجَّة الكبرى علام"، فأنتم جميعا من لون واحد، وإنْ اختلف درجةً وكثافةً. وتأبى أن تكون، أو أن تصبح، على "صورة الاقتصاد"، فـ "الدكاكين"، في "السوق الحزبية السياسية"، تظلُّ في أمكنتها لا تخلوها لِمَا يشبه "السوبر ماركت"، أو "المول"، وكأنَّ المستحيل بعينه، في حياتنا الحزبية السياسية، أن يتضاءل الرقم "18 (حزباً)" حتى يغدو "3 (تيَّارات حزبية)"، أحدهم "وطني (البرنامج)"، وثانيهم "قومي اشتراكي"، وثالثهم "إسلامي"؛ ولا أعْرِف "السرِّ اللاهوتي" لهذه "الأقانيم (البرامج) الثلاثة"!
إنَّني لستُ ضد الرقم "18"، ولو أصبح "180"؛ ولكنني ضد أن يُوْلَد حزب جديد من أتفه وأصغر اختلاف بين اثنين من المواطنين، وكأنَّ الحزبية السياسية (والفكرية) هي "الاختلاف" الذي لا يَضْرِب جذوره عميقا في "الاتِّفاق"، وكأنَّ "الاتِّفاق"، إذا ما وُجِد، إمَّا أن يكون خالصاً لا أثر فيه للاختلاف وإمَّا أن يكون في ضعفٍ، يُعْجِزه عن التحكُّم حتى في أتفه وأصغر اختلاف. ولستُ ضد الرقم "3"، ولو أصبح "2"، على أنْ نجيد لعبة "تصغير الرقم"، فـ "المنافسة (الحزبية السياسية)"، المستوفية لشروط تشابهها، أو تماثُلِها، مع "المنافسة في الاقتصاد الحر"، هي وحدها الطريق إلى "تصغير الرقم"، الذي لن يَصْغُر أبدا بالتمني، والمناشدة، والوعظ، ولا بـ "الإرادة الحرَّة" للأحزاب، فـ "المجتمع" هو الذي يمكنه، وينبغي له، أن يَنْتَخِب ويختار ويصطفي، أي أن يكون "داروينياً" لجهة علاقته بـ "الكثرة الحزبية"، فاعطني مجتمعاً، خُلِق، سياسيا، على مثال "الداروينية"، أُعْطيكَ حياة حزبية، فيها كل معاني "الحياة"، وكل معاني "الحزبية".
من قبل، قرَّرت الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية بما يُجْبِر الشركات الهشَّة الصغيرة على التوحُّد والاندماج، فإذا هي أخفقت، غدت غير مستوفية الشرط القانوني لوجودها. أمَّا هذا الذي توافقت عليه السلطتان التنفيذية والتشريعية فيمكن تفسيره، جزئيا، على أنَّه تعبير عن رغبتهما المشترَكة في أن يصبح لدينا شركات كبرى عملاقة كتلك التي في الغرب.
القرار ذاته؛ ولكن في صورة أخرى، فـ "السلطتان"، وبعدما فهمتا تطوَّر الحياة السياسية كما يفهم شرطي السير ازدحام الشوارع بالسيارات، قرَّرتا أن تحلا أزمة السير، ليس بتنظيمه، وتطوير شبكة الطرقات، وإنَّما بخفض عدد السيارات.
لستُ مع الأحزاب، التي اختارت "الانتحاب" يوم "الانتخاب"؛ ولكنني مع "المنطق"، الذي أثخنته أمراض وجراح المصالح الشخصية والفئوية الضيقة بين "طرفي النزاع"، الذي لا يكترث له المواطنون والشعب والمجتمع؛ ويكفي أن تنحاز إلى المنطق حتى تنحاز عن الطرفين اللذين على "تضادهما" يتَّحِدان في كونهما لا يمثِّلان "جسم" المجتمع، وإنَّما "ظله".
هل بـ "قرار إداري" تَوَحَّد المتعدِّد من الشركات في الغرب؟ كلا، ليس بـ "قرار إداري"؛ وإنَّما بالمنافسة، وفي المنافسة، الحرَّة، فدعوا السمك يتصارع، في حرِّية، فيتفاوت نموَّا، فيلتهم كبيره صغيره. وهل لـ "الشركات السياسية (الأحزاب)"، في الغرب قانونا للتطوُّر يختلف، في الجوهر والأساس، عن قوانين السوق الحرة "الداروينية"؟!
لقد حاروا في وصف "قانون الأحزاب الجديد"، الذي ظهرت فيه الحكومة على أنَّها أكثر رأفة بالأحزاب من "البرلمان"، نوابا وأعيانا؛ وكيف لهؤلاء (النواب والأعيان) أن يكونوا على غير ما هم عليه من عداء فطري لـ "الحزبية السياسية (والفكرية)" وهم الثمرة المرَّة لانتفاء الحياة الحزبية في مجتمعنا، فمنسوبهم يعلو بهبوط منسوب الحياة الحزبية، التي يعلو منسوبها بهبوط منسوبهم؟!
بعضهم وصفه بأنَّه "إعادة تنظيم للحياة الحزبية"؛ وبعضهم وصفه بأنَّه قرار "إعدام الحياة الحزبية"، أو قرار "ذبح الأحزاب بسكِّين البرلمانية العشائرية"؛ وبعضهم وصفه بأنَّه قرار يُرغِم بعض الأحزاب (التي تستلطفها الحكومة ونوابها) على التوحُّد والاندماج حتى يصبح ممكنا حزبيا موازنة نفوذ إسلاميين كـ "العمل الإسلامي"؛ وبعضهم وصفه بأنَّه "الابن الشرعي" لقانون الانتخابات (قانون الصوت الواحد) فالقانون الجديد (قانون الأحزاب) سينتهي عمليا إلى تأكيد أنَّ "الانتخابات اللا سياسية" خير وأبقى من "الانتخابات السياسية".
السؤال، سؤال الحياة الحزبية السياسية الحقيقة، الذي لم يُجَب بَعْد هو الآتي: كيف نجعل المواطن مُقْتَنِعاً ومؤمناً بجدوى وأهمية وضرورة الحياة الحزبية؟ حتى الآن، لم نَقُم إلا بما جعلنا ننجح في زيادة المواطن كُفْرا بالحياة الحزبية حتى إذا ظَهَر كفره هذا وتأكَّد قُلْنا في حسرة وألم: بعدما تعوَّد (أي بعدما عوَّدناه) قلَّة الأكل.. مات جوعاً!".
الداروينية الحزبية
إنَّنا نقول دائما بأهمية وضرورة أن تكون لدينا حياة حزبية؛ ونقول، في الوقت نفسه، بأهمية وضرورة "تنظيمها". هنا، يَظْهَر التناقض الذي لم نوفَّق، حتى الآن، في حلِّه بما يُدْخِل "الروح"، أي "الحزبية السياسية"، في "الجسد" من حياتنا الديمقراطية، فـ "التنظيم" لحياتنا الحزبية لم نَعْرِف منه إلا ما يذهب بها. إنَّ بعضاً من أهم مقوِّمات الحل تدلنا عليه "الطبيعة"، التي أرى فيها أهم "كتاب" يمكن ويجب أن نتعلَّم منه مبادئ وأصول الحياة الديمقراطية، فانْظروا في بعضٍ من فصول هذا الكتاب لعلَّكم تقفون على "الجواب".. جواب "سؤال الحزبية".
في العلاقة بين الكائن الحي وبيئته نرى، أوَّلا، أنَّ الكائن الحي، كل كائن حي، لا بد له من أن يتكاثر ويتناسل؛ ثمَّ نرى أنَّ بعضا من نسله يبقى على قيد الحياة. الكائن الحي يلِد العشرات، أو المئات، أو الآلاف، من أمثاله، أي من أفراد نوعه. وكل مولود لديه من الصفات والخواص ما يجعله مختلفا عن "أشقائه". وفي هذا الاختلاف يكمن سر التطور، فالمولود الذي يبقى على قيد الحياة، ويتكاثر ويتناسل بالتالي، إنَّما هو الذي لديه من الصفات والخواص ما يمكِّنه من العيش في البيئة التي وُلِدَ فيها؛ أمَّا غيره من المواليد الأشقاء فلا مفرَّ له من الهلاك؛ ذلك لأنَّ البيئة التي وُلِدَ فيها، والتي هي تؤدِّي دور "الناخب" في المجتمعات الديمقراطية، لم تجد فيه (أي في هذا "المرشَّح" من بين عشرات ومئات وآلاف "المرشَّحين" من أشقائه) من الصفات والخواص ما يؤهِّله لأنْ يكون ابناً لها، فلم تُدْلِ بصوتها لمصلحته، أي لم تنتخبه وتصطفيه وتختاره.
الذي لديه، في صفاته وخواصه، أي في فطرته، ذلك "التفوُّق" هو الذي تنتخبه الطبيعة أو البيئة التي وُلِدَ فيها، وهو الذي، في تكاثره وتناسله، يُوَرِّث نسله صفاته "الجيِّدة"، فيستمر ويعظم التطور والارتقاء جيلا بعد جيل حتى يتحوَّل "النوع القديم" إلى نوع جديد أكثر تطورا ورقيَّا.
"ديمقراطية الطبيعة" هي "العدالة" التي كلها "قسوة"، ولا أثر فيها لتلك الصفة الحميدة في ميزاننا الأخلاقي والتي نسميها "الرحمة"، وكأنَّ "التربية الصالحة" هي التي تنبذ الرحمة وتأخذ بالقسوة!
إنني لم أقل كل ذلك إلا لأُوضِّح أنَّ "الديمقراطية"، في معناها الأم والحقيقي، يمكننا وينبغي لنا تعلمها من "الطبيعة"، أي من تلك العلاقة بين الكائن الحي وبيئته، والتي شرحنا بعضا من أوجهها وجوانبها المهمة.
من هذا "المعلِّم الأعظم"، نتعلَّم، أوَّلا، ضرورة وأهمية إظهار "الاختلاف"، فالخطوة الأولى على طريق التطور والتقدُّم هي تمكين المجتمع، أفرادا وجماعات، من أن يُظهِر، في حرِّية تامة، تنوعه واختلافه، في الميول والأفكار والمعتقدات والرؤى.. والأحزاب، فبهذا "التكاثر الحزبي السياسي ـ الفكري"، الذي نتطيَّر منه، ونحاول "تثليثه"، أي جعله ثلاثة أحزاب لا غير، نخطو تلك الخطوة الأولى.
ونتعلَّم، أيضا، أن ليس كل ما يُولَد يستحق البقاء، فالحزب أو الاتجاه أو الفكر الذي لديه من الصفات والخواص ما يسمح له بأن يكون ابناً للبيئة الاجتماعية والتاريخية هو وحده يبقى على قيد الحياة، وتنتخبه "البيئة" عبر الناس.
على أنَّ البيئة الاجتماعية والتاريخية لن تكون "ناخبا ديمقراطيا" إلا إذا كانت حرَّة من ضغوط وتأثيرات كل من لا يملك من ميزان يزن به "الصواب" و"الخطأ"، "الخير" و"الشر"، "المفيد" و"الضار"، "الحلال" و"الحرام"، إلا الميزان المُخْتَل بقوة المصالح الضيِّقة.
إنَّ البيئة الاجتماعية والتاريخية "المصطنعة" هي التي ما زالت حتى الآن تتولى الانتخاب والاختيار في مجتمعاتنا، فلا يسود من الأفكار والمعتقدات والاتجاهات السياسية والأدبية والفنية إلا ما تستحسنه وتستنسبه المصالح الضيِّقة.
نريد مجتمعا "تطبَّعت" بيئته الاجتماعية والتاريخية بما يسمح له بإظهار كل تنوعه واختلافه، فينتخب ويختار، في حرية تامة، ما يلبِّي احتياجاته، ويخدم مصالحه، من بين كل ما ظهر فيه من اتجاهات وأفكار وأحزاب.
لقد فضَّلوا "الحل الإداري الاصطناعي" على "الحل الديمقراطي الطبيعي"، فتقرَّر اتِّخاذ الرقم "500" شرطاً (من شروط عدة) لترخيص وزارة الداخلية لأيِّ حزب في العمل السياسي؛ مع أنَّ تجربة الحياة الحزبية في مواطِن الديمقراطية تُظْهِر أنَّ "المنافسة السياسية (والفكرية) الحرَّة" هي وحدها الطريق إلى ما يشبه "الاصطفاء (أو الانتخاب) الطبيعي"، أي إلى تمكين السمك الحزبي الكبير من التهام السمك الحزبي الصغير؛ كما تُظْهِر أنَّ هذا الالتهام، ومهما اتَّسع واشتد، لا يمنع عشرات ومئات الأحزاب السياسية من العيش في جوار قلَّة قليلة من الأحزاب الثقيلة الضخمة.
إذا بدأتم بـ "الأحزاب"، وبالدعوة إلى "اختصارها"؛ لأنَّ خير الأحزاب ما قلَّ ودل، فلن تصلوا إلى شيء، فالخطوة الأولى والكبرى على الطريق المؤدِّية إلى حياة حزبية حقيقية إنَّما هي المواطِن (فرداً وجماعةً) المُسلَّح بحقوقه وحرِّياته السياسية والديمقراطية كاملة غير منقوصة، والذي أقْنَعَتْهُ "الدولة" بأنَّ ممارَسَتِه لها هي الطريق إلى "الجنَّة"، وبأنَّ استنكافه عن ممارَسَتِها هي الطريق إلى "جهنَّم"، والذي جاءته "الديمقراطية"، مع"الانتخابات"، بما يؤكِّد له أنَّ التغيير الذي يريد، والذي يحتاج إليه، وله مصلحة حقيقية فيه، يمكن، ويجب، أن يأتي من هذه الطريق، ومنها فحسب.
أمَّا أن تأتيه "الديمقراطية"، مع "الانتخابات"، بما يؤكِّد له أن لا جديد تحت الشمس، وأنَّ أسياده في العهد القديم أسياده في العهد الديمقراطي الجديد، فهذا إنْ أدَّى إلى شيء فإنَّما يؤدِّي إلى مزيدٍ من "الأحزاب ـ الدكاكين"، التي هي في منزلة "الأطراف" بالنسبة إلى "أفراد"، هُم "المواطنون غير العاديين"، وإلى مزيدٍ من صمت "الأكثرية الصامتة" من "المواطنين العاديين".
لِنَزِدْ عدد الديمقراطيين بين "المواطنين العاديين"، فلا ديمقراطية تنشأ وتزدهر في مجتمع قلَّ عدد الديمقراطيين من أبنائه، فَمِنْ هذه "القِلَّة" تأتي تلك "الكثرة" في عدد الأحزاب التي ليست بأحزاب؛ وغنيٌ عن البيان أنْ لا حياة ديمقراطية حقيقية حيث تَجْتَمِع هذه "الكثرة" مع تلك "القِلَّة".
ضرورة بَعْث المجتمع
عندما نتحدَّث عن المرأة، لا يفوتنا ترديد عبارة التعزية الشهيرة "المرأة نصف المجتمع"؛ ولكننا لو أنصفنا الحقيقة (فلا إنصاف للمرأة ما لم ننصف الحقيقة) لقلنا إنَّ المرأة ليست بنصف المجتمع إلاَّ من الوجهة الكمية والعددية الصرف، فهي من الوجهة الاجتماعية والسياسية والقانونية والحقوقية.. ليست إلاَّ "أقلية".
وعلى النسق ذاته، نتحدث عن "المجتمع" نفسه، فـ "المجتمع" إنَّما هو "الكل".. هو الأكبر من كل مكوِّناته وعناصره ومشتقاته؛ هو الأكبر من الدولة والحكومة والطبقات والطوائف والأحزاب والنقابات.. هو، ومن وجهة نظر حسابية، "حاصل جَمْع" أفراده.
أمَّا لو أنصفنا الحقيقة لقلنا إنَّ "المجتمع"، والمجتمع عندنا على وجه الخصوص، ليس إلاَّ "أقلية" سياسية وقانونية وحقوقية، فأضعف القوى في مجتمعنا هي مجتمعنا ذاته. إنَّه، والحق يُقال، "المهدي الحقيقي" الذي لم يخرج من سردابه بعد.
وأحسب أنَّ خير مقياس نقيس به درجة التطوُّر الديمقراطي للمجتمع هو "الجماعية"، التي نردِّد في أمرها، وفي أمر أهميتها وضرورتها، قولان: "الاتحاد قوَّة"، و"فرِّق تَسُدْ".
وإذا ما أردنا لـ "الجماعية"، ثقافةً وعملاً ونشاطاً ومهمةً وهدفاً، أن تنشأ وتنمو وتتطوَّر.. وتسود، فلا بدَّ لنا أوَّلاً من تمييزها من "الحزبية السياسية (والفكرية)"، أي من الحياة السياسية التي تقوم على "الأحزاب"، فـ "الأحزاب" في مجتمعنا هي كالظلال التي فقدت أجسامها، أو كعظام رميم.
وضآلة وجودها لا تعني أنَّ مجتمعنا في دورة من "الكساد الحزبي"، فلو أنَّ بضاعة ما، تلبِّي حاجة ما، تضاءل كثيراً عرضها في السوق لرأينا الطلب عليها يقوى ويشتد، فيرتفع، بالتالي، سعرها. أمَّا لو كانت البضاعة ذاتها غير مستوفية لشرط "تلبية حاجة ما" لرأينا تضاؤل المعروض منها يقترن بتراجع الطلب عليها، وبانهيار سعرها، وصولاً إلى دركه الأسفل، أي إلى رفض المُسْتَهْلِك الحصول عليها ولو بلا ثمن؛ والأحزاب عندنا هي كهذه البضاعة.
إحياء "المجتمع" عندنا، أو النفخ في جسده من روح الديمقراطية، لن يبدأ، ويجب ألاَّ يبدأ، من "الأحزاب" التي لدينا الآن، فالموتى، وإنْ ظلَّ لهم سلطان (وسلطان قوي) على الأحياء، لن يتمكَّنوا أبداً من الإتيان بمعجزة "الإحياء".
البداية إنَّما تكون من المجتمع ذاته، فأوَّل حقٍّ ينبغي للمجتمع التمتُّع به، وممارسته، هو "الحق في التنظيم الذاتي المستقل"؛ و"المصلحة المشترَكة" هي التي يجب أن تكون قوام هذا التنظيم.
إنَّ "الطوباوية" بعينها أنْ ندعو إلى غرس "الجماعية" في مجتمعنا في غير تربة "المصلحة (الحقيقية الواقعية لا الوهمية)"، فعالمنا وتاريخنا محكوم بـ "نزاع المصالح"؛ ولقد حان لضحايا الأوهام المثالية، وهم الغالبية العظمى من البشر، أن يتمثَّلوا تجربتهم المرَّة، في درسها التاريخي الأوَّل، وهو "مَنْ يجهل مصلحته لا يمكنه أبداً الدفاع عنها".
وهذا "التنظيم الذاتي المستقل" لا يمتُّ بصلة لا إلى "الأحزاب السياسية"، ولا إلى "النقابات المهنية"، فـ "الحزبية" و"النقابية" عندنا ما عادتا، منذ زمن طويل، بأداة صالحة للتغيير، وغدتا جزءاً لا يتجزأ من قوى الإعاقة والتعطيل والفساد.
الأخذ بـ "الجماعية"، ثقافةً وعملاً ونشاطاً، سيُنْتِج أوَّل ما يُنْتِج تلك الظاهرة التي تعرفها المجتمعات في الغرب.. ظاهرة "جماعات الضغط"، و"جماعات المصالح الخاصة".
إنَّ كل جماعة يجمع أفرادها مصلحة أو مصالح معيَّنة، ينبغي لها، ويحق، أن تنتظم ذاتياً وديمقراطياً، من أجل الدفاع عن مصالحها المشترَكة، وفي مقدَّمها "المصلحة المهنية"، التي يكمن فيها "الحق في الدفاع عن الوجود المعيشي".
"المصالح (المهنية والمعيشية) المشترَكة" يمكن ويجب أن تكون، بدايةً، في نطاقها أو حيِّزها الاجتماعي الأضيق، أي في شركة أو مؤسسة ما؛ ولكنها ستسير حتماً في مسار صاعد، فهذا النطاق أو الحيِّز سيتَّسع في استمرار، وسنرى، بالتالي، عشرات، فمئات، فآلاف، الأفراد ممَّن تجمعهم مصالح مشترَكة ينظِّمون أنفسهم بأنفسهم، ومن أجل أنفسهم في المقام الأوَّل.
ويكفي أن تزدهر هذه "الجماعية" في مجتمعنا، وتكثر وتتكاثر "جماعات الضغط" و"جماعات المصالح الخاصة"، حتى تتهيَّأ "بنية تحتية" حقيقية لحياة حزبية سياسية جديدة، فالأحزاب السياسية (والفكرية) الجديدة يمكن عندئذٍ أن تنشأ، وأن تضرب لها جذوراً عميقة في تلك الجماعات، وأن تصبح بالتالي كهيئة أركان أصبح لها جيشاً.
إنَّ إحياء المجتمع مع التأسيس لحياة حزبية سياسية حقيقية، يمكن ويجب أن يبدأ من إقرار وضمان حق كل جماعة في أن تنظِّم نفسها بنفسها، دفاعاً عمِّا يجمع أفرادها من مصالح حقيقية واقعية ملموسة.
ثقافة الخوف من الانتماء الحزبي
نريد حياة حزبية، بكل ما لـ "الحياة" و"الحزبية" من معانٍ، ولكننا لم نحقِّق بعد هذا الذي نريد، فلماذا؟
رئيس وزراء أردني قديم أجاب عن هذا السؤال، الذي، على ما نعتقد، لا يستبد بتفكير غالبية المواطنين، الذين لم يعرفوا بعد من "التنمية الاقتصادية" ما يمكِّنهم من تلبية حاجاتهم الأولية والأساسية، التي بعد، وبفضل، تلبيتها يصبح في مقدورهم الانصراف عن الأمر الاقتصادي ـ المعيشي إلى الأمر السياسي، الذي، في أهميته النسبية، لا يعدل الآن سوى قطرة في بحر الأمر الأول، فالبشر، ونحن منهم، ينبغي لهم أن يلبوا حاجاتهم المادية الأساسية قبل، ومن أجل، أن يذهبوا، بعقولهم وقلوبهم، إلى عوالم الفن والأدب والفلسفة.. والسياسة. وغني عن البيان أن "التنمية الاقتصادية" المستوفية لشرطها الاجتماعي ـ الشعبي، أي التي تلمس غالبية المواطنين، لمس اليد، منافعها وفوائدها هي التي تؤسس لحياة سياسية ـ حزبية تشتد فيها حاجة المجتمع إلى نبذ الغلو والتطرف والتعصب والأساليب المنافية للديمقراطية في العمل السياسي.
في إجابته قال إن انتشار وترسُّخ "ثقافة الخوف من الانتماء الحزبي" هو الذي يحول بين مجتمعنا وبين قيام وتطور حياة حزبية حقيقية، والتوسع في "التنمية السياسية والديمقراطية"، فالمواطن يريد، ويرغب في، الانتماء الحزبي، ولكنه يخاف ويخشى العواقب الأمنية أو الشبيهة بها. وأحسب أن الإجابة تلك صحيحة إذا ما فُهِِمت على أنها إجابة جزئية وغير مكتملة، فالمواطن عندنا ليس لديه ما يكفي من الميل إلى الانتماء الحزبي لأسباب بعضها، وليس كلها، يكمن في "ثقافة الخوف" تلك، كما أن التوسع في التعليل والتفسير يملي علينا معاملة "السبب"، الذي أتى على ذكره رئيس الوزراء وهو "ثقافة الخوف من الانتماء الحزبي"، على أنه "نتيجة"، فإجابته إنما تدعونا إلى السؤال الأهم وهو السؤال عن سبب انتشار وترسُّخ تلك الثقافة المنافية تماما لـ "الثقافة الديمقراطية"، بكل أوجهها وصورها.
لِمَ يحتفظ مجتمعنا، على الرغم من كل ما توصَّل إليه حتى الآن من تطور ديمقراطي، بهذا القدر من "ثقافة الخوف من الانتماء الحزبي"، والذي كلما زاد قلَّت "الثقافة الديمقراطية"؟
أحسب أن هذا السؤال، الذي تلده إجابة رئيس الوزراء، هو الذي يستأهل الإجابة أكثر من سواه.
إن "ثقافة الخوف" لا يمكن فهمها وتفسيرها إلا بصفة كونها انعكاسا لواقع موضوعي، ونتاجا لتجربة فردية وجماعية لم تصبح بعد جزءا من الماضي ضئيل التأثير في حاضرنا، فالمواطن نال كثيرا مما يُعدُّ حقا ديمقراطيا له، ولكن تجربته الشخصية، وتجارب غيره، لم تأتِ بما يكفي من النتائج التي من شأنها أن تجعله يحيا بمقدار متضائل من "ثقافة الخوف من الانتماء الحزبي". لقد فعل المواطن كل ما تمليه عليه فعله "ثقافة الخوف" تلك كفعل النأي بنفسه عن الحياة السياسية ـ الحزبية، ولكن ما الذي فعلته (أقول "فعلته" ولا أقول "قالته") الدولة، أو الحكومة، في سبيل القضاء على البنية التحتية لـ "ثقافة الخوف"؟!
وحتى لا ننسب كل هذا "الشر"، أي كل هذا الموات في حياتنا الحزبية، إلى "ثقافة الخوف" تلك، لا بد من الانتقال من "الأمني" إلى "السياسي" في التفسير والتعليل، فالمواطن، وبعد تحرره من الخوف من عواقب الانتماء الحزبي، ينبغي له أن يملك من التجربة السياسية ما يشعره، ويعزز لديه الشعور، بجدوى الأحزاب والحياة الحزبية، فما هي أهمية حياة حزبية تنجح في تلبية حاجته إلى "التفسير" إذا ما نجحت، ولكنها تفشل في تلبية حاجته إلى "التغيير"؟!
6.2 مليون نسمة عدد سكَّان الأردن؛ أمَّا عدد "سكَّان"، أي أعضاء، الأحزاب السياسية الأردنية فلا يزيد عن 10 آلاف "نسمة"، أي عضو، يتركَّزون في 18 حزباً مُرخَّصاً لها؛ وكلُّ حزب ينبغي له، قبل، ومن أجل، أن تُرخَّص له وزارة الداخلية في مزاولة العمل السياسي أن يَضُمَّ في صفوفه ما لا يقل عن 500 عضو مؤسِّس.
الأردنيون، عموماً، هم شعب "مُسيَّس"؛ بل هم من طائفة الشعوب الأكثر اهتماماً بالسياسة، فنادِراً ما تَجِد أردنياً لا يتحدَّث في السياسة، أو لا يدلي برأيه في الشؤون والقضايا السياسية المختلفة، أو لا يَنْفَعِل سياسياً، أو لا يُنْفِق جزءاً كبيراً من وقته اليومي في متابعة الأحداث والتطوُّرات السياسية عَبْر نشرات الأخبار والبرامج السياسية التي تبثها القنوات الفضائية (السياسية في المقام الأوَّل) كقناة "الجزيرة".
إنَّها ظواهر أردنية كالأحاجي، فلو جاءكَ أحدهم وقال لكَ إنَّ هناك مجتمعاً يزيد عدد أفراده عن ستَّة ملايين، منهم عشرة آلاف شخص فحسب ينتسبون إلى أحزاب سياسية (مُرخَّص وغير مُرخَّص لها) لاسْتَنْتَجتَ أنَّ هذا المجتمع لا يَعْرِف شيئاً يُعْتَدُّ به من الحياة الديمقراطية، ومن الحياة السياسية، ومن الاهتمام بالسياسة؛ أمَّا لو قال لكَ إنَّ هناكَ مجتمعاً تُهَيْمِن السياسة على معظم أفراده، تفكيراً وكلاماًَ ومشاعر، ويُسْمَح فيه، في الوقت نفسه، بحياةٍ حزبية، لاسْتَنْتَجتَ أنَّ مئات الآلاف من أفراده ينتسبون إلى الأحزاب السياسية.
الشعب الأردني، والحقُّ يقال، شعب "سياسي"؛ ولكن في معنى مخصوص، فهو شعب ذكي سياسياً، ومثقَّف سياسياً، يعي جيِّداً بواطن وخفايا الأمور السياسية، يرى دائماً الأكمة وما وراءها، وإنْ حَمَلَتْهُ ظروف عيشه، التي يشقُّ على الديمقراطية العيش فيها، على أن يُوْكِل أمْر تمثيله البرلماني إلى أناسٍ لا يملكون ما يملكه المواطِن العادي من الأهلية السياسية.
ولو أرَدْنا التحدُّث عن الشعب الأردني، لجهة صلته بالسياسة، في لغة فلسفية، لقُلْنا إنَّه ينتمي إلى تلك الفلسفة التي تقتصر مهمتها على "تفسير العالم"، فالأردني مؤمِنٌ ومُقْتَنِعٌ بأهمية وضرورة وجدوى فهم ومعرفة وتفسير عالمه السياسي الواقعي؛ ولكنَّه غير مؤمِن، وغير مُقْتَنِع، بأهمية وضرورة وجدوى أن يسعى إلى "التغيير"، وأن يكون جزءاً من أداته، ومن أداته الحزبية على وجه الخصوص، فتجربة العمل الحزبي أقْنَعَتْهُ بأنَّ الأحزاب السياسية التي عرفها واختبرها ليست بأداة صالحة للتغيير الذي يحتاج إليه، ويريده، وبأنَّها لو كانت صالحة، أو يمكن أن تصبح صالحة، لما استطاعت إلى التغيير سبيلاً؛ لأنَّها تعيش في "بيئة سياسية" غير ملائمة لتغييرٍ كذاك.
من قبل، أي حتى العاشر من نيسان 2007، عَرَفَ الأردن كثرة في الأحزاب السياسية، أي في "دكاكين" تسمَّى "أحزاباً"، فالحزب كان ممكناً أن يُوْلَد ولادة قانونية بخمسين عضواً مؤسِّساً فحسب، فاخترع "المُصْلِحون"، أو "الإصلاحيون"، نظرية للإصلاح السياسي قوامها أنْ لا سبيل إلى الإصلاح السياسي قبل "الاختصار" و"التركيز"، فكثرة الأحزاب، أو وجود أكثر من ثلاثة أحزاب "ثقيلة الوزن الشعبي والسياسي"، يتسبَّب بـ "زحامٍ"، يتسبَّب بـ "عرقلة السير"، فكيف لعربة الإصلاح السياسي أن تتقدَّم في سيرها في مسارٍ يشتد فيه الزحام؟!
الرقم 3
"الأرقام" هي ضَرْبٌ من "التجريد الخالص"، فالمرء ليس في مقدوره الذهني أن يفضِّل رقما على رقم، أو أن ينحاز إلى رقم ضد رقم، إلاَّ إذا قام أوَّلا بكسو هذا "العَظْم الرياضي" لحما، أي حوَّل الرقم من "المجرَّد" إلى "الملموس".
ومع ذلك، يظل الرقم 3 أشهر الأرقام جميعاً؛ ففي القرآن، تتضمَّن "البسملة" الله والرحمان والرحيم، وفي الإنجيل، يتضمَّن ما يشبه "البسملة" الآب والابن والروح القدس؛ وفي الفلسفة، نقف على "الثلاثية الهيجلية" الشهيرة، والتي ظهرت في الدياليكتيك المادي لماركس وإنجلز على هيئة قانون من أهم القوانين العامة للتطور في الطبيعة والتاريخ والمجتمع والفكر؛ أمَّا في الأردن، فالرقم 3 هو المفضَّل لحياة حزبية؛ والأردنيون ينتظرون الأحزاب الثلاثة الكبيرة كمن ينتظر سقوط السماء على الأرض. حتى الشر يبلغ منتهاه بالرقم 3، فنقول: "رماه بثالثة الأثافي".
إنَّنا جميعا "نتمنى" الحياة الحزبية، فـ "الموات الحزبي" هو، حتى الآن، جوهر الحياة السياسية لمجتمعنا، الذي في الليل يتكلَّم عن الأحزاب السياسية، وعن ضرورتها وأهميتها والحاجة إليها، فإذا النهار طلع وتجلَّى مُحيَ كلام الليل، وعُدْنا إلى الاستمساك بكل انتماء منافٍ لحياة حزبية حقَّاً، فما نَيْل "الأحزاب" بالتمني!
وكل ما قُمنا به حتى الآن، أي منذ زمن سياسي طويل، من أجل التأسيس لحياة حزبية لم يتمخَّض إلا عمَّا يقيم الدليل على أنَّ "عَمَلَنا" كان، وظلَّ، "كلاما"، وكأنَّنا لا نَعْرِف إلا ما يشبه "الصلاة" طريقا إلى "الخلاص الحزبي"، فتارةً ننحو على مجتمعنا العاقِر (حزبيا) باللوم، وطورا ننحو على "الأحزاب" ذاتها باللوم، فهي وفيرة، كثيرة، متكاثرة، يَزْدِحم بها "شارعنا السياسي"، فَتَقِلُّ "الحركة"، التي هي "سكون" لا يَظْهَر إلا لنا على أنَّه "حركة".. وهي تأبى "التعدُّدية الحزبية الرشيدة"، تتصارع تَصارُع الديكة (من غير أن تبيض ولو "بيضة الديك") أمام جمهور لو نَطَق لخاطبهم قائلا "إلام الخلف بينكم إلام وهذه الضجَّة الكبرى علام"، فأنتم جميعا من لون واحد، وإنْ اختلف درجةً وكثافةً. وتأبى أن تكون، أو أن تصبح، على "صورة الاقتصاد"، فـ "الدكاكين"، في "السوق الحزبية السياسية"، تظلُّ في أمكنتها لا تخلوها لِمَا يشبه "السوبر ماركت"، أو "المول"، وكأنَّ المستحيل بعينه، في حياتنا الحزبية السياسية، أن يتضاءل الرقم "18 (حزباً)" حتى يغدو "3 (تيَّارات حزبية)"، أحدهم "وطني (البرنامج)"، وثانيهم "قومي اشتراكي"، وثالثهم "إسلامي"؛ ولا أعْرِف "السرِّ اللاهوتي" لهذه "الأقانيم (البرامج) الثلاثة"!
إنَّني لستُ ضد الرقم "18"، ولو أصبح "180"؛ ولكنني ضد أن يُوْلَد حزب جديد من أتفه وأصغر اختلاف بين اثنين من المواطنين، وكأنَّ الحزبية السياسية (والفكرية) هي "الاختلاف" الذي لا يَضْرِب جذوره عميقا في "الاتِّفاق"، وكأنَّ "الاتِّفاق"، إذا ما وُجِد، إمَّا أن يكون خالصاً لا أثر فيه للاختلاف وإمَّا أن يكون في ضعفٍ، يُعْجِزه عن التحكُّم حتى في أتفه وأصغر اختلاف. ولستُ ضد الرقم "3"، ولو أصبح "2"، على أنْ نجيد لعبة "تصغير الرقم"، فـ "المنافسة (الحزبية السياسية)"، المستوفية لشروط تشابهها، أو تماثُلِها، مع "المنافسة في الاقتصاد الحر"، هي وحدها الطريق إلى "تصغير الرقم"، الذي لن يَصْغُر أبدا بالتمني، والمناشدة، والوعظ، ولا بـ "الإرادة الحرَّة" للأحزاب، فـ "المجتمع" هو الذي يمكنه، وينبغي له، أن يَنْتَخِب ويختار ويصطفي، أي أن يكون "داروينياً" لجهة علاقته بـ "الكثرة الحزبية"، فاعطني مجتمعاً، خُلِق، سياسيا، على مثال "الداروينية"، أُعْطيكَ حياة حزبية، فيها كل معاني "الحياة"، وكل معاني "الحزبية".
من قبل، قرَّرت الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية بما يُجْبِر الشركات الهشَّة الصغيرة على التوحُّد والاندماج، فإذا هي أخفقت، غدت غير مستوفية الشرط القانوني لوجودها. أمَّا هذا الذي توافقت عليه السلطتان التنفيذية والتشريعية فيمكن تفسيره، جزئيا، على أنَّه تعبير عن رغبتهما المشترَكة في أن يصبح لدينا شركات كبرى عملاقة كتلك التي في الغرب.
القرار ذاته؛ ولكن في صورة أخرى، فـ "السلطتان"، وبعدما فهمتا تطوَّر الحياة السياسية كما يفهم شرطي السير ازدحام الشوارع بالسيارات، قرَّرتا أن تحلا أزمة السير، ليس بتنظيمه، وتطوير شبكة الطرقات، وإنَّما بخفض عدد السيارات.
لستُ مع الأحزاب، التي اختارت "الانتحاب" يوم "الانتخاب"؛ ولكنني مع "المنطق"، الذي أثخنته أمراض وجراح المصالح الشخصية والفئوية الضيقة بين "طرفي النزاع"، الذي لا يكترث له المواطنون والشعب والمجتمع؛ ويكفي أن تنحاز إلى المنطق حتى تنحاز عن الطرفين اللذين على "تضادهما" يتَّحِدان في كونهما لا يمثِّلان "جسم" المجتمع، وإنَّما "ظله".
هل بـ "قرار إداري" تَوَحَّد المتعدِّد من الشركات في الغرب؟ كلا، ليس بـ "قرار إداري"؛ وإنَّما بالمنافسة، وفي المنافسة، الحرَّة، فدعوا السمك يتصارع، في حرِّية، فيتفاوت نموَّا، فيلتهم كبيره صغيره. وهل لـ "الشركات السياسية (الأحزاب)"، في الغرب قانونا للتطوُّر يختلف، في الجوهر والأساس، عن قوانين السوق الحرة "الداروينية"؟!
لقد حاروا في وصف "قانون الأحزاب الجديد"، الذي ظهرت فيه الحكومة على أنَّها أكثر رأفة بالأحزاب من "البرلمان"، نوابا وأعيانا؛ وكيف لهؤلاء (النواب والأعيان) أن يكونوا على غير ما هم عليه من عداء فطري لـ "الحزبية السياسية (والفكرية)" وهم الثمرة المرَّة لانتفاء الحياة الحزبية في مجتمعنا، فمنسوبهم يعلو بهبوط منسوب الحياة الحزبية، التي يعلو منسوبها بهبوط منسوبهم؟!
بعضهم وصفه بأنَّه "إعادة تنظيم للحياة الحزبية"؛ وبعضهم وصفه بأنَّه قرار "إعدام الحياة الحزبية"، أو قرار "ذبح الأحزاب بسكِّين البرلمانية العشائرية"؛ وبعضهم وصفه بأنَّه قرار يُرغِم بعض الأحزاب (التي تستلطفها الحكومة ونوابها) على التوحُّد والاندماج حتى يصبح ممكنا حزبيا موازنة نفوذ إسلاميين كـ "العمل الإسلامي"؛ وبعضهم وصفه بأنَّه "الابن الشرعي" لقانون الانتخابات (قانون الصوت الواحد) فالقانون الجديد (قانون الأحزاب) سينتهي عمليا إلى تأكيد أنَّ "الانتخابات اللا سياسية" خير وأبقى من "الانتخابات السياسية".
السؤال، سؤال الحياة الحزبية السياسية الحقيقة، الذي لم يُجَب بَعْد هو الآتي: كيف نجعل المواطن مُقْتَنِعاً ومؤمناً بجدوى وأهمية وضرورة الحياة الحزبية؟ حتى الآن، لم نَقُم إلا بما جعلنا ننجح في زيادة المواطن كُفْرا بالحياة الحزبية حتى إذا ظَهَر كفره هذا وتأكَّد قُلْنا في حسرة وألم: بعدما تعوَّد (أي بعدما عوَّدناه) قلَّة الأكل.. مات جوعاً!".
الداروينية الحزبية
إنَّنا نقول دائما بأهمية وضرورة أن تكون لدينا حياة حزبية؛ ونقول، في الوقت نفسه، بأهمية وضرورة "تنظيمها". هنا، يَظْهَر التناقض الذي لم نوفَّق، حتى الآن، في حلِّه بما يُدْخِل "الروح"، أي "الحزبية السياسية"، في "الجسد" من حياتنا الديمقراطية، فـ "التنظيم" لحياتنا الحزبية لم نَعْرِف منه إلا ما يذهب بها. إنَّ بعضاً من أهم مقوِّمات الحل تدلنا عليه "الطبيعة"، التي أرى فيها أهم "كتاب" يمكن ويجب أن نتعلَّم منه مبادئ وأصول الحياة الديمقراطية، فانْظروا في بعضٍ من فصول هذا الكتاب لعلَّكم تقفون على "الجواب".. جواب "سؤال الحزبية".
في العلاقة بين الكائن الحي وبيئته نرى، أوَّلا، أنَّ الكائن الحي، كل كائن حي، لا بد له من أن يتكاثر ويتناسل؛ ثمَّ نرى أنَّ بعضا من نسله يبقى على قيد الحياة. الكائن الحي يلِد العشرات، أو المئات، أو الآلاف، من أمثاله، أي من أفراد نوعه. وكل مولود لديه من الصفات والخواص ما يجعله مختلفا عن "أشقائه". وفي هذا الاختلاف يكمن سر التطور، فالمولود الذي يبقى على قيد الحياة، ويتكاثر ويتناسل بالتالي، إنَّما هو الذي لديه من الصفات والخواص ما يمكِّنه من العيش في البيئة التي وُلِدَ فيها؛ أمَّا غيره من المواليد الأشقاء فلا مفرَّ له من الهلاك؛ ذلك لأنَّ البيئة التي وُلِدَ فيها، والتي هي تؤدِّي دور "الناخب" في المجتمعات الديمقراطية، لم تجد فيه (أي في هذا "المرشَّح" من بين عشرات ومئات وآلاف "المرشَّحين" من أشقائه) من الصفات والخواص ما يؤهِّله لأنْ يكون ابناً لها، فلم تُدْلِ بصوتها لمصلحته، أي لم تنتخبه وتصطفيه وتختاره.
الذي لديه، في صفاته وخواصه، أي في فطرته، ذلك "التفوُّق" هو الذي تنتخبه الطبيعة أو البيئة التي وُلِدَ فيها، وهو الذي، في تكاثره وتناسله، يُوَرِّث نسله صفاته "الجيِّدة"، فيستمر ويعظم التطور والارتقاء جيلا بعد جيل حتى يتحوَّل "النوع القديم" إلى نوع جديد أكثر تطورا ورقيَّا.
"ديمقراطية الطبيعة" هي "العدالة" التي كلها "قسوة"، ولا أثر فيها لتلك الصفة الحميدة في ميزاننا الأخلاقي والتي نسميها "الرحمة"، وكأنَّ "التربية الصالحة" هي التي تنبذ الرحمة وتأخذ بالقسوة!
إنني لم أقل كل ذلك إلا لأُوضِّح أنَّ "الديمقراطية"، في معناها الأم والحقيقي، يمكننا وينبغي لنا تعلمها من "الطبيعة"، أي من تلك العلاقة بين الكائن الحي وبيئته، والتي شرحنا بعضا من أوجهها وجوانبها المهمة.
من هذا "المعلِّم الأعظم"، نتعلَّم، أوَّلا، ضرورة وأهمية إظهار "الاختلاف"، فالخطوة الأولى على طريق التطور والتقدُّم هي تمكين المجتمع، أفرادا وجماعات، من أن يُظهِر، في حرِّية تامة، تنوعه واختلافه، في الميول والأفكار والمعتقدات والرؤى.. والأحزاب، فبهذا "التكاثر الحزبي السياسي ـ الفكري"، الذي نتطيَّر منه، ونحاول "تثليثه"، أي جعله ثلاثة أحزاب لا غير، نخطو تلك الخطوة الأولى.
ونتعلَّم، أيضا، أن ليس كل ما يُولَد يستحق البقاء، فالحزب أو الاتجاه أو الفكر الذي لديه من الصفات والخواص ما يسمح له بأن يكون ابناً للبيئة الاجتماعية والتاريخية هو وحده يبقى على قيد الحياة، وتنتخبه "البيئة" عبر الناس.
على أنَّ البيئة الاجتماعية والتاريخية لن تكون "ناخبا ديمقراطيا" إلا إذا كانت حرَّة من ضغوط وتأثيرات كل من لا يملك من ميزان يزن به "الصواب" و"الخطأ"، "الخير" و"الشر"، "المفيد" و"الضار"، "الحلال" و"الحرام"، إلا الميزان المُخْتَل بقوة المصالح الضيِّقة.
إنَّ البيئة الاجتماعية والتاريخية "المصطنعة" هي التي ما زالت حتى الآن تتولى الانتخاب والاختيار في مجتمعاتنا، فلا يسود من الأفكار والمعتقدات والاتجاهات السياسية والأدبية والفنية إلا ما تستحسنه وتستنسبه المصالح الضيِّقة.
نريد مجتمعا "تطبَّعت" بيئته الاجتماعية والتاريخية بما يسمح له بإظهار كل تنوعه واختلافه، فينتخب ويختار، في حرية تامة، ما يلبِّي احتياجاته، ويخدم مصالحه، من بين كل ما ظهر فيه من اتجاهات وأفكار وأحزاب.
لقد فضَّلوا "الحل الإداري الاصطناعي" على "الحل الديمقراطي الطبيعي"، فتقرَّر اتِّخاذ الرقم "500" شرطاً (من شروط عدة) لترخيص وزارة الداخلية لأيِّ حزب في العمل السياسي؛ مع أنَّ تجربة الحياة الحزبية في مواطِن الديمقراطية تُظْهِر أنَّ "المنافسة السياسية (والفكرية) الحرَّة" هي وحدها الطريق إلى ما يشبه "الاصطفاء (أو الانتخاب) الطبيعي"، أي إلى تمكين السمك الحزبي الكبير من التهام السمك الحزبي الصغير؛ كما تُظْهِر أنَّ هذا الالتهام، ومهما اتَّسع واشتد، لا يمنع عشرات ومئات الأحزاب السياسية من العيش في جوار قلَّة قليلة من الأحزاب الثقيلة الضخمة.
إذا بدأتم بـ "الأحزاب"، وبالدعوة إلى "اختصارها"؛ لأنَّ خير الأحزاب ما قلَّ ودل، فلن تصلوا إلى شيء، فالخطوة الأولى والكبرى على الطريق المؤدِّية إلى حياة حزبية حقيقية إنَّما هي المواطِن (فرداً وجماعةً) المُسلَّح بحقوقه وحرِّياته السياسية والديمقراطية كاملة غير منقوصة، والذي أقْنَعَتْهُ "الدولة" بأنَّ ممارَسَتِه لها هي الطريق إلى "الجنَّة"، وبأنَّ استنكافه عن ممارَسَتِها هي الطريق إلى "جهنَّم"، والذي جاءته "الديمقراطية"، مع"الانتخابات"، بما يؤكِّد له أنَّ التغيير الذي يريد، والذي يحتاج إليه، وله مصلحة حقيقية فيه، يمكن، ويجب، أن يأتي من هذه الطريق، ومنها فحسب.
أمَّا أن تأتيه "الديمقراطية"، مع "الانتخابات"، بما يؤكِّد له أن لا جديد تحت الشمس، وأنَّ أسياده في العهد القديم أسياده في العهد الديمقراطي الجديد، فهذا إنْ أدَّى إلى شيء فإنَّما يؤدِّي إلى مزيدٍ من "الأحزاب ـ الدكاكين"، التي هي في منزلة "الأطراف" بالنسبة إلى "أفراد"، هُم "المواطنون غير العاديين"، وإلى مزيدٍ من صمت "الأكثرية الصامتة" من "المواطنين العاديين".
لِنَزِدْ عدد الديمقراطيين بين "المواطنين العاديين"، فلا ديمقراطية تنشأ وتزدهر في مجتمع قلَّ عدد الديمقراطيين من أبنائه، فَمِنْ هذه "القِلَّة" تأتي تلك "الكثرة" في عدد الأحزاب التي ليست بأحزاب؛ وغنيٌ عن البيان أنْ لا حياة ديمقراطية حقيقية حيث تَجْتَمِع هذه "الكثرة" مع تلك "القِلَّة".
ضرورة بَعْث المجتمع
عندما نتحدَّث عن المرأة، لا يفوتنا ترديد عبارة التعزية الشهيرة "المرأة نصف المجتمع"؛ ولكننا لو أنصفنا الحقيقة (فلا إنصاف للمرأة ما لم ننصف الحقيقة) لقلنا إنَّ المرأة ليست بنصف المجتمع إلاَّ من الوجهة الكمية والعددية الصرف، فهي من الوجهة الاجتماعية والسياسية والقانونية والحقوقية.. ليست إلاَّ "أقلية".
وعلى النسق ذاته، نتحدث عن "المجتمع" نفسه، فـ "المجتمع" إنَّما هو "الكل".. هو الأكبر من كل مكوِّناته وعناصره ومشتقاته؛ هو الأكبر من الدولة والحكومة والطبقات والطوائف والأحزاب والنقابات.. هو، ومن وجهة نظر حسابية، "حاصل جَمْع" أفراده.
أمَّا لو أنصفنا الحقيقة لقلنا إنَّ "المجتمع"، والمجتمع عندنا على وجه الخصوص، ليس إلاَّ "أقلية" سياسية وقانونية وحقوقية، فأضعف القوى في مجتمعنا هي مجتمعنا ذاته. إنَّه، والحق يُقال، "المهدي الحقيقي" الذي لم يخرج من سردابه بعد.
وأحسب أنَّ خير مقياس نقيس به درجة التطوُّر الديمقراطي للمجتمع هو "الجماعية"، التي نردِّد في أمرها، وفي أمر أهميتها وضرورتها، قولان: "الاتحاد قوَّة"، و"فرِّق تَسُدْ".
وإذا ما أردنا لـ "الجماعية"، ثقافةً وعملاً ونشاطاً ومهمةً وهدفاً، أن تنشأ وتنمو وتتطوَّر.. وتسود، فلا بدَّ لنا أوَّلاً من تمييزها من "الحزبية السياسية (والفكرية)"، أي من الحياة السياسية التي تقوم على "الأحزاب"، فـ "الأحزاب" في مجتمعنا هي كالظلال التي فقدت أجسامها، أو كعظام رميم.
وضآلة وجودها لا تعني أنَّ مجتمعنا في دورة من "الكساد الحزبي"، فلو أنَّ بضاعة ما، تلبِّي حاجة ما، تضاءل كثيراً عرضها في السوق لرأينا الطلب عليها يقوى ويشتد، فيرتفع، بالتالي، سعرها. أمَّا لو كانت البضاعة ذاتها غير مستوفية لشرط "تلبية حاجة ما" لرأينا تضاؤل المعروض منها يقترن بتراجع الطلب عليها، وبانهيار سعرها، وصولاً إلى دركه الأسفل، أي إلى رفض المُسْتَهْلِك الحصول عليها ولو بلا ثمن؛ والأحزاب عندنا هي كهذه البضاعة.
إحياء "المجتمع" عندنا، أو النفخ في جسده من روح الديمقراطية، لن يبدأ، ويجب ألاَّ يبدأ، من "الأحزاب" التي لدينا الآن، فالموتى، وإنْ ظلَّ لهم سلطان (وسلطان قوي) على الأحياء، لن يتمكَّنوا أبداً من الإتيان بمعجزة "الإحياء".
البداية إنَّما تكون من المجتمع ذاته، فأوَّل حقٍّ ينبغي للمجتمع التمتُّع به، وممارسته، هو "الحق في التنظيم الذاتي المستقل"؛ و"المصلحة المشترَكة" هي التي يجب أن تكون قوام هذا التنظيم.
إنَّ "الطوباوية" بعينها أنْ ندعو إلى غرس "الجماعية" في مجتمعنا في غير تربة "المصلحة (الحقيقية الواقعية لا الوهمية)"، فعالمنا وتاريخنا محكوم بـ "نزاع المصالح"؛ ولقد حان لضحايا الأوهام المثالية، وهم الغالبية العظمى من البشر، أن يتمثَّلوا تجربتهم المرَّة، في درسها التاريخي الأوَّل، وهو "مَنْ يجهل مصلحته لا يمكنه أبداً الدفاع عنها".
وهذا "التنظيم الذاتي المستقل" لا يمتُّ بصلة لا إلى "الأحزاب السياسية"، ولا إلى "النقابات المهنية"، فـ "الحزبية" و"النقابية" عندنا ما عادتا، منذ زمن طويل، بأداة صالحة للتغيير، وغدتا جزءاً لا يتجزأ من قوى الإعاقة والتعطيل والفساد.
الأخذ بـ "الجماعية"، ثقافةً وعملاً ونشاطاً، سيُنْتِج أوَّل ما يُنْتِج تلك الظاهرة التي تعرفها المجتمعات في الغرب.. ظاهرة "جماعات الضغط"، و"جماعات المصالح الخاصة".
إنَّ كل جماعة يجمع أفرادها مصلحة أو مصالح معيَّنة، ينبغي لها، ويحق، أن تنتظم ذاتياً وديمقراطياً، من أجل الدفاع عن مصالحها المشترَكة، وفي مقدَّمها "المصلحة المهنية"، التي يكمن فيها "الحق في الدفاع عن الوجود المعيشي".
"المصالح (المهنية والمعيشية) المشترَكة" يمكن ويجب أن تكون، بدايةً، في نطاقها أو حيِّزها الاجتماعي الأضيق، أي في شركة أو مؤسسة ما؛ ولكنها ستسير حتماً في مسار صاعد، فهذا النطاق أو الحيِّز سيتَّسع في استمرار، وسنرى، بالتالي، عشرات، فمئات، فآلاف، الأفراد ممَّن تجمعهم مصالح مشترَكة ينظِّمون أنفسهم بأنفسهم، ومن أجل أنفسهم في المقام الأوَّل.
ويكفي أن تزدهر هذه "الجماعية" في مجتمعنا، وتكثر وتتكاثر "جماعات الضغط" و"جماعات المصالح الخاصة"، حتى تتهيَّأ "بنية تحتية" حقيقية لحياة حزبية سياسية جديدة، فالأحزاب السياسية (والفكرية) الجديدة يمكن عندئذٍ أن تنشأ، وأن تضرب لها جذوراً عميقة في تلك الجماعات، وأن تصبح بالتالي كهيئة أركان أصبح لها جيشاً.
إنَّ إحياء المجتمع مع التأسيس لحياة حزبية سياسية حقيقية، يمكن ويجب أن يبدأ من إقرار وضمان حق كل جماعة في أن تنظِّم نفسها بنفسها، دفاعاً عمِّا يجمع أفرادها من مصالح حقيقية واقعية ملموسة.
ثقافة الخوف من الانتماء الحزبي
نريد حياة حزبية، بكل ما لـ "الحياة" و"الحزبية" من معانٍ، ولكننا لم نحقِّق بعد هذا الذي نريد، فلماذا؟
رئيس وزراء أردني قديم أجاب عن هذا السؤال، الذي، على ما نعتقد، لا يستبد بتفكير غالبية المواطنين، الذين لم يعرفوا بعد من "التنمية الاقتصادية" ما يمكِّنهم من تلبية حاجاتهم الأولية والأساسية، التي بعد، وبفضل، تلبيتها يصبح في مقدورهم الانصراف عن الأمر الاقتصادي ـ المعيشي إلى الأمر السياسي، الذي، في أهميته النسبية، لا يعدل الآن سوى قطرة في بحر الأمر الأول، فالبشر، ونحن منهم، ينبغي لهم أن يلبوا حاجاتهم المادية الأساسية قبل، ومن أجل، أن يذهبوا، بعقولهم وقلوبهم، إلى عوالم الفن والأدب والفلسفة.. والسياسة. وغني عن البيان أن "التنمية الاقتصادية" المستوفية لشرطها الاجتماعي ـ الشعبي، أي التي تلمس غالبية المواطنين، لمس اليد، منافعها وفوائدها هي التي تؤسس لحياة سياسية ـ حزبية تشتد فيها حاجة المجتمع إلى نبذ الغلو والتطرف والتعصب والأساليب المنافية للديمقراطية في العمل السياسي.
في إجابته قال إن انتشار وترسُّخ "ثقافة الخوف من الانتماء الحزبي" هو الذي يحول بين مجتمعنا وبين قيام وتطور حياة حزبية حقيقية، والتوسع في "التنمية السياسية والديمقراطية"، فالمواطن يريد، ويرغب في، الانتماء الحزبي، ولكنه يخاف ويخشى العواقب الأمنية أو الشبيهة بها. وأحسب أن الإجابة تلك صحيحة إذا ما فُهِِمت على أنها إجابة جزئية وغير مكتملة، فالمواطن عندنا ليس لديه ما يكفي من الميل إلى الانتماء الحزبي لأسباب بعضها، وليس كلها، يكمن في "ثقافة الخوف" تلك، كما أن التوسع في التعليل والتفسير يملي علينا معاملة "السبب"، الذي أتى على ذكره رئيس الوزراء وهو "ثقافة الخوف من الانتماء الحزبي"، على أنه "نتيجة"، فإجابته إنما تدعونا إلى السؤال الأهم وهو السؤال عن سبب انتشار وترسُّخ تلك الثقافة المنافية تماما لـ "الثقافة الديمقراطية"، بكل أوجهها وصورها.
لِمَ يحتفظ مجتمعنا، على الرغم من كل ما توصَّل إليه حتى الآن من تطور ديمقراطي، بهذا القدر من "ثقافة الخوف من الانتماء الحزبي"، والذي كلما زاد قلَّت "الثقافة الديمقراطية"؟
أحسب أن هذا السؤال، الذي تلده إجابة رئيس الوزراء، هو الذي يستأهل الإجابة أكثر من سواه.
إن "ثقافة الخوف" لا يمكن فهمها وتفسيرها إلا بصفة كونها انعكاسا لواقع موضوعي، ونتاجا لتجربة فردية وجماعية لم تصبح بعد جزءا من الماضي ضئيل التأثير في حاضرنا، فالمواطن نال كثيرا مما يُعدُّ حقا ديمقراطيا له، ولكن تجربته الشخصية، وتجارب غيره، لم تأتِ بما يكفي من النتائج التي من شأنها أن تجعله يحيا بمقدار متضائل من "ثقافة الخوف من الانتماء الحزبي". لقد فعل المواطن كل ما تمليه عليه فعله "ثقافة الخوف" تلك كفعل النأي بنفسه عن الحياة السياسية ـ الحزبية، ولكن ما الذي فعلته (أقول "فعلته" ولا أقول "قالته") الدولة، أو الحكومة، في سبيل القضاء على البنية التحتية لـ "ثقافة الخوف"؟!
وحتى لا ننسب كل هذا "الشر"، أي كل هذا الموات في حياتنا الحزبية، إلى "ثقافة الخوف" تلك، لا بد من الانتقال من "الأمني" إلى "السياسي" في التفسير والتعليل، فالمواطن، وبعد تحرره من الخوف من عواقب الانتماء الحزبي، ينبغي له أن يملك من التجربة السياسية ما يشعره، ويعزز لديه الشعور، بجدوى الأحزاب والحياة الحزبية، فما هي أهمية حياة حزبية تنجح في تلبية حاجته إلى "التفسير" إذا ما نجحت، ولكنها تفشل في تلبية حاجته إلى "التغيير"؟!

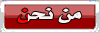





» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918