ما أشقى صاحب القلم لمّا يبتعد عن ذكر الحقائق المعروفة فيتوصّل إلى اكتشاف الحقيقة غير المألوفة، لكنه يُصدمُ بعدم تجاوب الناشر مع ما كتب. وما أسعده لمّا، في نفس الأسبوع، تُصفّر الأقلام إلى بعضها البعض فيأتي صاحبَنا تأكيدٌ لرؤيته من طرف مداعب آخر للقلم.
فما لبثتُ أن دوّنتُ فكرة ظلت تلازمني مثل ظلّي لمدة أعوام حتّى جاءني تأكيد لصحتها من لدُن باحثين آخرين. كنتُ نشرتُ رأيا مفاده أنه لم يعُد للمعارضة السياسية معنى طالما أنها استُلبت إلى موضة اتهام الحُكام. وكنتُ وما زلتُ ألوم على السياسيين وعلى المعارضة بالخصوص عدم تتناولهم بالنقد المجتمع العربي ككلّ ليكتشفوا أنّه هو المُعطل للتغيير نحو التعددية الفكرية والسياسية. وهو تغيير حلمَت به نُخبنا لمدّة عقود، ويحوم خاصة حول مطلب تكريس الحريات وإرساء الديمقراطية. وما زلتُ أرى أنّ السبب في أنّ القليل فقط من ذلك الحُلم قد تحقق بينما الكثير باقٍ في وضع من الاحتقان الرهيب هو أنّ المثقف قد اختار الانسياق إلى موضة مناهضة الحكّام حتى تنحّى عن منصب المفكر والمربّي.
ففي نفس الأسبوع وإبّان نشر الرأي وصلتني نشرة من موقع ألماني فيها ملخّص لكتاب جديد للبريطاني "براين وياتكر" بعنوان "ما الذي حدث فعلا للشرق الأوسط؟". و يركز مؤلف الكتاب على الوَقع العنيف للعقلية الأبوية التي يسميها الكاتب الفلسطيني هشام شرابي "الأبوية المستحدثة" على "العقل المجتمعي" . فهذه العقلية، على حد قول الكاتب، هي التي قد أدت إلى وضعية لا نُحسد عليها، وليست شبيهة بأوضاع شعوب أخرى تواقة إلى الديمقراطية مثلنا، بل هي فريدة من نوعها. ويستنتج الكاتب ما معناه أنّ في البلاد العربية، صار المجتمع بأسره يقف أمام التغيير (لخّص الكتاب "جايمس م.دورساي" على موقع "قنطرة" الألماني).
فالذي أضيفه على مبحث شرابي وعلى خلاصة البريطاني "وايتكر" أنّ الأبوية قد أفرزت نوعا من الاستقالة الجماعية يسندها الاستلاب للسلطة، ما جعل كافة قوى المجتمع تتخذ غياب الديمقراطية ذريعة للتهوّر والاسترخاء والاكتفاء بالهزائم. ففي زمن فقدت فيه الأمة العربية ذاكرتها لتلك الأسباب، لا يسع مجتهدي التنوير إلاّ أن يساعدوا العقول المتقبلة للاستنارة على استعادة الذاكرة المفقودة. وهذا لا يعني استرداد الصور المؤلمة من التاريخ بقدر ما يعني تأليف صورة نموذجية للمجد العربي في زمانه (الآن) وفي مكانه (من المحيط إلى الخليج). والسبب في الانكباب على التأليف أنّ بقدر ما الاستقالة رهيبة ومخيفة، بقدر ما تُعزز حظوظنا في التسامي والسموّ والتجاوز والاستفاقة.
كمعلّم أواكب الشباب يوميا وأُبجّلهم على الكبار بسبب خروج هؤلاء الكبار من التاريخ طوعا، أميل إلى الظن أن حقبة التحمّس للديمقراطية من دون رويّة أو تدبر ولّت و انتهت (فترة التسعينيات)، وبالتالي أننا في مطلع حقبة جديدة أتمنى أن تتّسم بأكثر جدّية وعقلانية وحِرفية. و لا يعود تكسير المسار الديمقراطي أو تعطله أو بطؤه في غضون الحقبة المنقضية، لا لكسل نحن مولودون به أو مجبولون عليه، ولا لاحتقار ساستنا لنا . بل يعود تعثر الديمقراطية إلى خلل في منظومتين، واحدة خارجية والثانية ذاتية.
على الصعيد الخارجي: التناقض الرهيب الذي تصرفت به قوى الهيمنة العالمية إزاءنا. إذْ كانت من ناحية تزعم أن الحل الملائم لنا يتمثل في الديمقراطية، وكانت من ناحية أخرى تدعم التسلط والاضطهاد ضد شعوبنا وتدعم القمع ضده، معترفة ضمنيا أنّ الديمقراطية ليست ما يجب أن يطمح إليه عاقل منّا.
وفي الحقيقة قد سبق حقبة الحماس للديمقراطية فترة دامت عقدين من الزمن لا يمكن أن تؤهل العرب والمسلمين إلاّ لنقض الديمقراطية حتى قبل ولادتها. فقد عمدت قوى الهيمنة العالمية آنذاك إلى البدء باحتلال فلسطين وبتوطين اليهود فيها، ثمّ بشن حروب على المقاومة القُطرية للاستعمار المباشر. وأخيرا ما لبثت البلدان المستقلة أن استفاقت من سباتها نتيجة لمجهودات التنمية فيها، و التي تواصلت بين العقدين والأربعة عقود، حتى طلعت علينا تلك القوى بتحالف الثلاثين ضد بلد واحد من بلداننا (العراق 1991) . وهي فضيحة تاريخية على حساب الغزاة لا يغفرها عاقل في كل الأحوال، زيادة عن مهزلة الاحتلال في فلسطين. ثم تواصلت الحقبة المشوبة بالتخويف تارة، والمتميزة بالمساعدة تارة أخرى، إلى أن انتهت بذهاب بوش الابن بعد أن كررت "الديمقراطية" أخطاءها ضد واحدة من أفقر البلدان (أفغانستان 2001)، ثم أعادت الكرّة ضد واحدة من أغناها (العراق 2003). كان التطرّف حتى في اختيار كبش الفداء لهزيمة الديمقراطية قبل موتها في عقردارهم.
إذَن ماتت الديمقراطية على الأقل عند الغربيين. وكان ذلك إبّان تلك الغزوات الصليبية. وقد سبق أن نظّر لها، ضمنيا، الأمريكي "فوكوياما" لمّا أعلن عن موت السياسة (بداية التسعينات). ولكن موت السياسة، أو موت الديمقراطية بعد عقد من ذلك، ليس حجة على موتهما عند غير الغربيين. كما أنّ موت الديمقراطية في كل الحالات ليست حجة على الاعتقاد بموت ركائزها ومقوماتها وقيمها، من تعددية فكرية وسياسية مكرسة لحق الاختلاف عموما والاختلاف في الرأي على وجه الخصوص، وغيرها من الثوابت الإنسانية التي ساهم العرب والمسلمون في توليدها من صلب ثقافتهم قبل تمريرها إلى أوروبا بواسطة فلاسفتهم العظام.
على الصعيد الذاتي: كان تشجيع القوى المُهيمنة الغربية لنا باتخاذ الديمقراطية وسيلة للحُكم عندنا، ثم انسياقنا إلى هذه الفكرة مع عدم التروّي في التفكير، دليلا مذهلا على فشلنا في عملية التفكير حتى، ناهيك في عملية "زرع" الديمقراطية. فالقوى المهيمنة هي التي فكرت في مكاننا ونحن لم نفعل سوى أننا انقدنا إلى التقليد، ففشلت التجارب، وهو فشل للمجتمع العربي بأسره. وإذا بمثقفينا يلجئون إلى إسقاط فشل المجتمع على الحكّام فحسب، مثلما ذكرنا أعلاه. كما عمد مثقفونا إلى تثبيت هذه الفكرة المتحجرة لدى كافة شرائح المجتمع. ومنه صار المثقف، بالاشتراك مع المجتمع، مثل ذلك الطبيب المعتلّ الذي انكبّ، عن بُعد ومن دون اقتناع ولا إقناع، على معالجة من يعتقد أنه مريض (الحُكام)، أو هو مريض فعلا (مثلما تكونوا يُوَلّى عليكم" – حديث) دون أن يتماثل هو الأول إلى الشفاء من الداء المشترك.
وهل من تداوٍ من دون تشخيص للدّاء؟ من أغرب الغرائب أنك ترى المثقف العربي يصرف كل أنظاره عن موضع العلة (المجتمع ككل). وليس هنالك ما يُفسر هذه الاستقالة سوى فرضية أنّ الضمير العربي قد تمّ ابتياعه بالبترودولار إثر حرب 1973. إذ إلى حد ذلك التاريخ لم يكن المجتمع العربي في تونس أو في المغرب أو في مصر أو في الأردن أو في سوريا، أو في غيرها من المجتمعات التواقة إلى الديمقراطية، بعيدا عن استخدام آليات التعددية الفكرية والسياسية، بُعده عنها إبّان "حرب البترول" وشبه الانتصار العربي.
فرُبما لعب الازدهار الفُجئي للمجتمعات العربية المنتفعة من الغنى الفجئي للمجتمعات الخليجية آنذاك دورا معاكسا للإمداد المادي (معونات ومساعدات) والعيني (فرص الشغل في الخليج): تغليط المجتمع نفسه بنفسه وذلك بصرف أنظاره عن الشواغل الفكرية والتنويرية. وربما انسجم الوضع آنذاك على فحوى المثل الشعبي القائل "اطعم الفم تستحي العين". وفي الواقع قد استحت العقول والقلوب والبصائر. فهل انتقمنا من أنفسنا لآنّ تلك الحرب توقفت قبل هزيمة العدو، أم أنها لعنة المُهيمن الذي يُهزَم لأول مرة بعد حقبة الاستقلال القُطري، ويغتاظ من هزيمة مُتي بهاعلى حين غرّة؟
وفي المقابل كان لا بد أن يقترن الوعي بلزوم النهوض والرقي، بالبحث في الثقافة الجماعية للأمة عن معوقات التعددية وعن العراقيل التي تحول دوننا ودون قبول حق الاختلاف والرأي المخالف. وأوّل الأسئلة التي تتبادر للذهن في هذا المستوى: لماذا نحن لسنا متعددي الفكر ولسنا متسامحين مع الرأي الآخر؟ ألسنا بقادرين على استيعاب قيم ومفاهيم الديمقراطية، بالرغم من اعتقادنا أنّ هذه الأخيرة قد انقرضت بعدُ كوسيلة وأداة مثالية في موطن ميلادها؟
أمّا الإجابة فتتطلب، في مرحلة أولى، الحفر في الشخصية العربية الإسلامية عسى أن يتم العثور على ما هو معطبٌ فيها. وذلك ما قامت به قلة قلائل من المفكرين مثل هشام شرابي كما قدّمتُ أعلاه. ثم إنه لمِن ركائز الاجتهاد التنويري أن يراجع المجتهد الثابتَ والبديهيَّ في تربيتنا في ضوء ما توفره التربية العصرية من أدوات فعالة مثل الألسنيات والعلوم الدماغية بالأساس. ومن بين الوسائل نذكر المقاربتين التواصلية والتعاونية، ومقاربة التربية الأفقية، ومقاربة التربية من الأسفل إلى الأعلى، ومقاربة الحاجيات.أمّا غياب ذلك في ثقافتنا المعاصرة فهو الذي سنح فرصا أخرى متتالية للأبوية بأن تمادت في عرقلة التجارب الديمقراطية في بلدان مثل الجزائر و السودان وموريتانيا، أو في بُطئها في تونس وفي المغرب وفي الأردن وغيرها.
وإذا أخذنا موت الديمقراطية في الغرب كمسَلّمة، وإذا قبِلنا بالتفكير في وضعنا بكل تروّ، فسوف نرى أننا بالأحرى في بداية دورة جديدة. أو سنرى أنه من المستحبّ أن نؤمن بأننا هناك. لماذا؟ لأنّنا إذا أردنا أن نرفض فكرة أننا تأخرنا نتيجة عدم توفقنا في إرساء الديمقراطية (علما بأنّ المجتمعات لا تتقدم ولا تتأخر، يقول الفيلسوف "أمرسمن"، بل تتغيّر)، وجب علينا الإيمان بضرورة أن نتأخر منهجيا لكي نأخذ مسافاتنا بالكامل. لكي لا نحرق المراحل مرة أخرى.
وبناء على التأخر المنهجي يتكون التعددية، ليس الديمقراطية، هي الأساس لبناء نمط من التعايش في إطار النُّظم الموجودة والمؤسسات المتوفرة في مجتمعاتنا حاليا. فلا شيء سيتغيّر نحو الأفضل لو كررت بعض الفصائل (الإسلام السياسي) خطأها المنهجي في النظر إلى التعددية على أنها مشروطة بتبديل نظام الحكم أو على أنها مطية لتبديله؟ بل التعددية تكريس لاجتهاد تنويري، تربوي وفلسفي، واسع النطاق. وهي بالتالي ممارسة يومية من شأنها أن تُسهل على المواطن العربي المرور من الطور الحالي إلى ما هو أفضل؛ في الفكر وفي تحريك الثقافة وتنميتها، في مرحلة تمهيدية، ثم لتموين الفكر السياسي العام بالرؤى والأفكار، في مرحلة موالية. وليس من حق أية جهة سياسية أو هيئة من هيئات المجتمع المدني أن تفرض نمطا معينا على مجتمع سنعتبره من هنا فصاعد بمثابة طالب العلم؛ طالب التدريب على التفكير الأفقي و التبادلي و التعددي. إذ المُهمة مهمة المعلّم و المفكر والأديب والشاعر والكاتب ولصحفي.
في الختام، لا يسع كافة مجتهدي التنوير إلاّ أن يتحرّوا في مسألة سيطرة الذهنية الأبوية وتحوّلها إلى إطار متزمت مستحدث. فبقدر صحة الطرح الذي مفاده أنّ الأبوية تُعدّ من الأسباب الرئيسة لعرقلة التمشي التعددي عند العرب والمسلمين، بقدر ما وجب إمعان النظر في تدارس المسألة بأكثر عمق، بل وبعرضها للمناقشة والمساءلة. والغرض من ذلك أنّ نتيجة البحث والحوار قد تفضي إلى إجماع على حلّ من الحلول. ولا ضير في أن يتعلّم المواطن العربي، افتراضا أنّ الأبوية المفرطة هي التي تشكل فعلا العائق الأساس أمام تغيير ما بالنفس، كيف يمحي ما تعلّم (الأبوية) لكي يكون قادرا على تنصيب منظومة مستحدثة للتربية، أو واحدة ترعى الأبوية وأخرى، موازية لها، توكَلُ لها مهمة تنمية العلاقات العرْضية. ويتم إنجاز ذلك بطبيعة الحال في مجال العلاقة بين الأب والأبناء، بين رئيس القبيلة ومنظوريه، بين رأس العشيرة أو قائد الطائفة ومن يعودون بالنظر إليهما. ومَن لا يعرف كيف يفرّغ ما تعلّم ثمّ يعيد التعلّم، لا يُعتبر مُواكبا لمُقاربة التربية في القرن الواحد والعشرين، كما أكدته وطبّقته كثير من المحافل التربوية العالمية.
فما لبثتُ أن دوّنتُ فكرة ظلت تلازمني مثل ظلّي لمدة أعوام حتّى جاءني تأكيد لصحتها من لدُن باحثين آخرين. كنتُ نشرتُ رأيا مفاده أنه لم يعُد للمعارضة السياسية معنى طالما أنها استُلبت إلى موضة اتهام الحُكام. وكنتُ وما زلتُ ألوم على السياسيين وعلى المعارضة بالخصوص عدم تتناولهم بالنقد المجتمع العربي ككلّ ليكتشفوا أنّه هو المُعطل للتغيير نحو التعددية الفكرية والسياسية. وهو تغيير حلمَت به نُخبنا لمدّة عقود، ويحوم خاصة حول مطلب تكريس الحريات وإرساء الديمقراطية. وما زلتُ أرى أنّ السبب في أنّ القليل فقط من ذلك الحُلم قد تحقق بينما الكثير باقٍ في وضع من الاحتقان الرهيب هو أنّ المثقف قد اختار الانسياق إلى موضة مناهضة الحكّام حتى تنحّى عن منصب المفكر والمربّي.
ففي نفس الأسبوع وإبّان نشر الرأي وصلتني نشرة من موقع ألماني فيها ملخّص لكتاب جديد للبريطاني "براين وياتكر" بعنوان "ما الذي حدث فعلا للشرق الأوسط؟". و يركز مؤلف الكتاب على الوَقع العنيف للعقلية الأبوية التي يسميها الكاتب الفلسطيني هشام شرابي "الأبوية المستحدثة" على "العقل المجتمعي" . فهذه العقلية، على حد قول الكاتب، هي التي قد أدت إلى وضعية لا نُحسد عليها، وليست شبيهة بأوضاع شعوب أخرى تواقة إلى الديمقراطية مثلنا، بل هي فريدة من نوعها. ويستنتج الكاتب ما معناه أنّ في البلاد العربية، صار المجتمع بأسره يقف أمام التغيير (لخّص الكتاب "جايمس م.دورساي" على موقع "قنطرة" الألماني).
فالذي أضيفه على مبحث شرابي وعلى خلاصة البريطاني "وايتكر" أنّ الأبوية قد أفرزت نوعا من الاستقالة الجماعية يسندها الاستلاب للسلطة، ما جعل كافة قوى المجتمع تتخذ غياب الديمقراطية ذريعة للتهوّر والاسترخاء والاكتفاء بالهزائم. ففي زمن فقدت فيه الأمة العربية ذاكرتها لتلك الأسباب، لا يسع مجتهدي التنوير إلاّ أن يساعدوا العقول المتقبلة للاستنارة على استعادة الذاكرة المفقودة. وهذا لا يعني استرداد الصور المؤلمة من التاريخ بقدر ما يعني تأليف صورة نموذجية للمجد العربي في زمانه (الآن) وفي مكانه (من المحيط إلى الخليج). والسبب في الانكباب على التأليف أنّ بقدر ما الاستقالة رهيبة ومخيفة، بقدر ما تُعزز حظوظنا في التسامي والسموّ والتجاوز والاستفاقة.
كمعلّم أواكب الشباب يوميا وأُبجّلهم على الكبار بسبب خروج هؤلاء الكبار من التاريخ طوعا، أميل إلى الظن أن حقبة التحمّس للديمقراطية من دون رويّة أو تدبر ولّت و انتهت (فترة التسعينيات)، وبالتالي أننا في مطلع حقبة جديدة أتمنى أن تتّسم بأكثر جدّية وعقلانية وحِرفية. و لا يعود تكسير المسار الديمقراطي أو تعطله أو بطؤه في غضون الحقبة المنقضية، لا لكسل نحن مولودون به أو مجبولون عليه، ولا لاحتقار ساستنا لنا . بل يعود تعثر الديمقراطية إلى خلل في منظومتين، واحدة خارجية والثانية ذاتية.
على الصعيد الخارجي: التناقض الرهيب الذي تصرفت به قوى الهيمنة العالمية إزاءنا. إذْ كانت من ناحية تزعم أن الحل الملائم لنا يتمثل في الديمقراطية، وكانت من ناحية أخرى تدعم التسلط والاضطهاد ضد شعوبنا وتدعم القمع ضده، معترفة ضمنيا أنّ الديمقراطية ليست ما يجب أن يطمح إليه عاقل منّا.
وفي الحقيقة قد سبق حقبة الحماس للديمقراطية فترة دامت عقدين من الزمن لا يمكن أن تؤهل العرب والمسلمين إلاّ لنقض الديمقراطية حتى قبل ولادتها. فقد عمدت قوى الهيمنة العالمية آنذاك إلى البدء باحتلال فلسطين وبتوطين اليهود فيها، ثمّ بشن حروب على المقاومة القُطرية للاستعمار المباشر. وأخيرا ما لبثت البلدان المستقلة أن استفاقت من سباتها نتيجة لمجهودات التنمية فيها، و التي تواصلت بين العقدين والأربعة عقود، حتى طلعت علينا تلك القوى بتحالف الثلاثين ضد بلد واحد من بلداننا (العراق 1991) . وهي فضيحة تاريخية على حساب الغزاة لا يغفرها عاقل في كل الأحوال، زيادة عن مهزلة الاحتلال في فلسطين. ثم تواصلت الحقبة المشوبة بالتخويف تارة، والمتميزة بالمساعدة تارة أخرى، إلى أن انتهت بذهاب بوش الابن بعد أن كررت "الديمقراطية" أخطاءها ضد واحدة من أفقر البلدان (أفغانستان 2001)، ثم أعادت الكرّة ضد واحدة من أغناها (العراق 2003). كان التطرّف حتى في اختيار كبش الفداء لهزيمة الديمقراطية قبل موتها في عقردارهم.
إذَن ماتت الديمقراطية على الأقل عند الغربيين. وكان ذلك إبّان تلك الغزوات الصليبية. وقد سبق أن نظّر لها، ضمنيا، الأمريكي "فوكوياما" لمّا أعلن عن موت السياسة (بداية التسعينات). ولكن موت السياسة، أو موت الديمقراطية بعد عقد من ذلك، ليس حجة على موتهما عند غير الغربيين. كما أنّ موت الديمقراطية في كل الحالات ليست حجة على الاعتقاد بموت ركائزها ومقوماتها وقيمها، من تعددية فكرية وسياسية مكرسة لحق الاختلاف عموما والاختلاف في الرأي على وجه الخصوص، وغيرها من الثوابت الإنسانية التي ساهم العرب والمسلمون في توليدها من صلب ثقافتهم قبل تمريرها إلى أوروبا بواسطة فلاسفتهم العظام.
على الصعيد الذاتي: كان تشجيع القوى المُهيمنة الغربية لنا باتخاذ الديمقراطية وسيلة للحُكم عندنا، ثم انسياقنا إلى هذه الفكرة مع عدم التروّي في التفكير، دليلا مذهلا على فشلنا في عملية التفكير حتى، ناهيك في عملية "زرع" الديمقراطية. فالقوى المهيمنة هي التي فكرت في مكاننا ونحن لم نفعل سوى أننا انقدنا إلى التقليد، ففشلت التجارب، وهو فشل للمجتمع العربي بأسره. وإذا بمثقفينا يلجئون إلى إسقاط فشل المجتمع على الحكّام فحسب، مثلما ذكرنا أعلاه. كما عمد مثقفونا إلى تثبيت هذه الفكرة المتحجرة لدى كافة شرائح المجتمع. ومنه صار المثقف، بالاشتراك مع المجتمع، مثل ذلك الطبيب المعتلّ الذي انكبّ، عن بُعد ومن دون اقتناع ولا إقناع، على معالجة من يعتقد أنه مريض (الحُكام)، أو هو مريض فعلا (مثلما تكونوا يُوَلّى عليكم" – حديث) دون أن يتماثل هو الأول إلى الشفاء من الداء المشترك.
وهل من تداوٍ من دون تشخيص للدّاء؟ من أغرب الغرائب أنك ترى المثقف العربي يصرف كل أنظاره عن موضع العلة (المجتمع ككل). وليس هنالك ما يُفسر هذه الاستقالة سوى فرضية أنّ الضمير العربي قد تمّ ابتياعه بالبترودولار إثر حرب 1973. إذ إلى حد ذلك التاريخ لم يكن المجتمع العربي في تونس أو في المغرب أو في مصر أو في الأردن أو في سوريا، أو في غيرها من المجتمعات التواقة إلى الديمقراطية، بعيدا عن استخدام آليات التعددية الفكرية والسياسية، بُعده عنها إبّان "حرب البترول" وشبه الانتصار العربي.
فرُبما لعب الازدهار الفُجئي للمجتمعات العربية المنتفعة من الغنى الفجئي للمجتمعات الخليجية آنذاك دورا معاكسا للإمداد المادي (معونات ومساعدات) والعيني (فرص الشغل في الخليج): تغليط المجتمع نفسه بنفسه وذلك بصرف أنظاره عن الشواغل الفكرية والتنويرية. وربما انسجم الوضع آنذاك على فحوى المثل الشعبي القائل "اطعم الفم تستحي العين". وفي الواقع قد استحت العقول والقلوب والبصائر. فهل انتقمنا من أنفسنا لآنّ تلك الحرب توقفت قبل هزيمة العدو، أم أنها لعنة المُهيمن الذي يُهزَم لأول مرة بعد حقبة الاستقلال القُطري، ويغتاظ من هزيمة مُتي بهاعلى حين غرّة؟
وفي المقابل كان لا بد أن يقترن الوعي بلزوم النهوض والرقي، بالبحث في الثقافة الجماعية للأمة عن معوقات التعددية وعن العراقيل التي تحول دوننا ودون قبول حق الاختلاف والرأي المخالف. وأوّل الأسئلة التي تتبادر للذهن في هذا المستوى: لماذا نحن لسنا متعددي الفكر ولسنا متسامحين مع الرأي الآخر؟ ألسنا بقادرين على استيعاب قيم ومفاهيم الديمقراطية، بالرغم من اعتقادنا أنّ هذه الأخيرة قد انقرضت بعدُ كوسيلة وأداة مثالية في موطن ميلادها؟
أمّا الإجابة فتتطلب، في مرحلة أولى، الحفر في الشخصية العربية الإسلامية عسى أن يتم العثور على ما هو معطبٌ فيها. وذلك ما قامت به قلة قلائل من المفكرين مثل هشام شرابي كما قدّمتُ أعلاه. ثم إنه لمِن ركائز الاجتهاد التنويري أن يراجع المجتهد الثابتَ والبديهيَّ في تربيتنا في ضوء ما توفره التربية العصرية من أدوات فعالة مثل الألسنيات والعلوم الدماغية بالأساس. ومن بين الوسائل نذكر المقاربتين التواصلية والتعاونية، ومقاربة التربية الأفقية، ومقاربة التربية من الأسفل إلى الأعلى، ومقاربة الحاجيات.أمّا غياب ذلك في ثقافتنا المعاصرة فهو الذي سنح فرصا أخرى متتالية للأبوية بأن تمادت في عرقلة التجارب الديمقراطية في بلدان مثل الجزائر و السودان وموريتانيا، أو في بُطئها في تونس وفي المغرب وفي الأردن وغيرها.
وإذا أخذنا موت الديمقراطية في الغرب كمسَلّمة، وإذا قبِلنا بالتفكير في وضعنا بكل تروّ، فسوف نرى أننا بالأحرى في بداية دورة جديدة. أو سنرى أنه من المستحبّ أن نؤمن بأننا هناك. لماذا؟ لأنّنا إذا أردنا أن نرفض فكرة أننا تأخرنا نتيجة عدم توفقنا في إرساء الديمقراطية (علما بأنّ المجتمعات لا تتقدم ولا تتأخر، يقول الفيلسوف "أمرسمن"، بل تتغيّر)، وجب علينا الإيمان بضرورة أن نتأخر منهجيا لكي نأخذ مسافاتنا بالكامل. لكي لا نحرق المراحل مرة أخرى.
وبناء على التأخر المنهجي يتكون التعددية، ليس الديمقراطية، هي الأساس لبناء نمط من التعايش في إطار النُّظم الموجودة والمؤسسات المتوفرة في مجتمعاتنا حاليا. فلا شيء سيتغيّر نحو الأفضل لو كررت بعض الفصائل (الإسلام السياسي) خطأها المنهجي في النظر إلى التعددية على أنها مشروطة بتبديل نظام الحكم أو على أنها مطية لتبديله؟ بل التعددية تكريس لاجتهاد تنويري، تربوي وفلسفي، واسع النطاق. وهي بالتالي ممارسة يومية من شأنها أن تُسهل على المواطن العربي المرور من الطور الحالي إلى ما هو أفضل؛ في الفكر وفي تحريك الثقافة وتنميتها، في مرحلة تمهيدية، ثم لتموين الفكر السياسي العام بالرؤى والأفكار، في مرحلة موالية. وليس من حق أية جهة سياسية أو هيئة من هيئات المجتمع المدني أن تفرض نمطا معينا على مجتمع سنعتبره من هنا فصاعد بمثابة طالب العلم؛ طالب التدريب على التفكير الأفقي و التبادلي و التعددي. إذ المُهمة مهمة المعلّم و المفكر والأديب والشاعر والكاتب ولصحفي.
في الختام، لا يسع كافة مجتهدي التنوير إلاّ أن يتحرّوا في مسألة سيطرة الذهنية الأبوية وتحوّلها إلى إطار متزمت مستحدث. فبقدر صحة الطرح الذي مفاده أنّ الأبوية تُعدّ من الأسباب الرئيسة لعرقلة التمشي التعددي عند العرب والمسلمين، بقدر ما وجب إمعان النظر في تدارس المسألة بأكثر عمق، بل وبعرضها للمناقشة والمساءلة. والغرض من ذلك أنّ نتيجة البحث والحوار قد تفضي إلى إجماع على حلّ من الحلول. ولا ضير في أن يتعلّم المواطن العربي، افتراضا أنّ الأبوية المفرطة هي التي تشكل فعلا العائق الأساس أمام تغيير ما بالنفس، كيف يمحي ما تعلّم (الأبوية) لكي يكون قادرا على تنصيب منظومة مستحدثة للتربية، أو واحدة ترعى الأبوية وأخرى، موازية لها، توكَلُ لها مهمة تنمية العلاقات العرْضية. ويتم إنجاز ذلك بطبيعة الحال في مجال العلاقة بين الأب والأبناء، بين رئيس القبيلة ومنظوريه، بين رأس العشيرة أو قائد الطائفة ومن يعودون بالنظر إليهما. ومَن لا يعرف كيف يفرّغ ما تعلّم ثمّ يعيد التعلّم، لا يُعتبر مُواكبا لمُقاربة التربية في القرن الواحد والعشرين، كما أكدته وطبّقته كثير من المحافل التربوية العالمية.

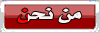



» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918