د. بشير موسى نافع
ليس ثمة ما يمكن به وصف السياسية التي تتبعها السلطة الفلسطينية في رام الله سوى الاستسلام الكامل، الاستسلام للإرادة الإسرائيلية، الاستسلام لوهم عملية تفاوض، لا من حدود أو أفق لها، والاستسلام لضغوط ووعود دولية، لم يعد من الممكن التفريق بين جدية تعاملها مع التفاوض من أجل السلام وانحيازها للجانب الإسرائيلي. حتى عندما يبدو بصيص ضوء في توازن القوى، بفعل توتر منخفض الدرجة بين واشنطن وتل أبيب، أو الانكشاف المستمر للسياسات الإسرائيلية أمام الرأي العام الغربي، أو بفعل تحرك شعبي فلسطيني وعربي، تأخذ السلطة الفلسطينية موقف من يطلق النار على قدميه.
تصاعدت الآمال الفلسطينية والعربية بعودة الحياة إلى مسار المفاوضات حتى قبل أن يفوز أوباما في انتخابات الرئاسة الامريكية. كان مسار أنابوليس قد أصيب بموت سريري منذ الشهور الأخيرة لإدارة بوش الابن؛ وفي ظل انهيار وضع بوش الداخلي وانحياز أركان إدارته المعروف للموقف الإسرائيلي، وترنح حكومة أولمرت، لم يعد هناك من أمل بإحراز أي تقدم يذكر، ولا حتى في استمرار المفاوضات من أجل المفاوضات. المشكلة، أن حكومة السلطة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس عباس وظله الجديد سلام فياض، كانت قد حسمت موقفها بالتزام خيار التفاوض، وطرح كل الخيارات الأخرى جانباً، بغض النظر عن أية اعتبارات سياسية أو استراتيجية. وبذلك، أصبح فوز أوباما أملاً منشوداً لعباس ورئيس حكومته والأنظمة العربية القليلة المتبنية له. وليس ثمة شك أن المؤشرات التي أطلقها أوباما، سراً وعلناً، كانت مختلفة عن المعهود، أو على الأقل عن الرئيس السابق له. لم يكن هناك ما يوحي بقدوم إدارة تقف خلف الحقوق الفلسطينية، بالطبع، ولكن ما رشح كان كافياً لإعطاء انطباع بجدية المرشح الديمقراطي للتعامل مع ملف المفاوضات، وحرصه على وضع نهاية لسياسة المعسكرات الفاصلة والقطعية التي اتبعتها إدارة سلفه، وأطلقت موجات من الحرب والعنف وعدم الاستقرار في المشرق، من ناحية، وانتهت وبالاً على وضع الولايات المتحدة العالمي، من ناحية أخرى. وفي التحضير لتولي أوباما مقاليد الحكم، تسارعت عجلة القمع الأمني في الضفة الغربية لكل من يشتبه بميول مقاومة، ووضعت القاهرة ثقلها كله خلف مشروع المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
أطلقت إدارة أوباما حملة كبرى من العلاقات العامة، الموجهة أصلاً وفي دائرتها الأكبر للراي العام العربي والإسلامي، من خطابي أنقره واسطنبول إلى خطاب جامعة القاهرة. وفي موازاة حملة العلاقات العامة، كلف الرئيس الجديد واحداً من أبرز السياسيين الامريكيين المخضرمين، جورج ميتشل، بتعهد ملف مفاوضات السلام العربية - الإسرائيلية، ومسارها الفلسطيني على وجه الخصوص. لم يكن سجل ميتشل يتضمن نجاحه الكبير في وضع نهاية للنزاع في إيرلندا الشمالية وحسب، بل أيضاً قيامه بدور كبير في الملف الفلسطيني في خضم الانتفاضة الفلسطينية الثانية خلال ولاية بوش الأولى. وبخلاف الشائع، كانت إدارة أوباما، وليس حكومة عباس، هي من وضع إيقاف الاستيطان شرطاً لانطلاق المفاوضات. والواضح أن ميتشل، الذي كان لاحظ خطورة استمرار التوسع الاستيطاني اليهودي على مشروع إقامة دولة فلسطينية، منذ تمثيله لإدارة بوش في جهود السلام، لعب دوراً أساسياً في إعادة مسألة الاستيطان إلى قلب عملية السلام.
بيد أن لا أوباما، ولا السلطة الفلسطينية، ولا الدول العربية، كان بإمكانها فرض إيقاف الاستيطان، ولا حتى الإيقاف المؤقت، على حكومة إسرائيلية يقودها نتنياهو في تحالف مع أمثال ليبرمان. والطرف الأساسي هنا هو إدارة أوباما. فقد أمضى الرئيس الامريكي الجديد عامه الأول في انشغال يومي لمحاولة تمرير خطته الخاصة بإصلاح النظام الصحي للولايات المتحدة، الخطة التي احتلت الموقع الأول والأبرز في برنامجه الانتخابي. يعرف أوباما أنه بدون تحقيق وعوده في هذا المجال، فسيحكم على إدارته بالفشل، حتى قبل أن يقترب موعد الانتخابات الرئاسية. وبدون تعزيز وضعه الداخلي، لا يستطيع رئيس أمريكي، مهما بلغ من براعة، أن يتعهد مبادرات ذات وزن على صعيد السياسة الخارجية. ولكن حتى على صعيد أولويات السياسة الخارجية، كما الحرب في أفغانستان والملف النووي الإيراني، كانت خطوات إدارة أوباما تواجه عقبات جمة، لم تكن في حسابات الرئيس ومعاونيه الكبار. في أفغانستان، اضطرت الإدارة، أولاً، إلى تقبل بتزييف الانتخابات وبقاء كرزاي في منصبه، بدون أن تكون على قناعة بجدوى وجوده في منصب الرئاسة؛ بينما كانت طالبان تحرز تقدماً وراء الآخر، ولم يعد في جعبة الإدارة سوى القفز في الهواء وزيادة عدد القوات الامريكية في شكل ملموس، بدون أن تعرف على وجه اليقين ما يمكن أن ينجم عن مثل هذه الخطوة. أما على صعيد الملف النووي الإيراني، فقد وقفت إدارة أوباما، ولم تزل، حائرة بين اعتماد سياسة الضربة العسكرية، وتحمل عواقبها غير المحسوبة وغير القابلة للتوقع، أو الاكتفاء بفرض عقوبات جديدة، لم يعد واضحاً، في ظل الإحجام الصيني والتلاعب الروسي، فعاليتها أو المدى الذي يمكن أن تصل إليه.
كما غيره في العالم، كان نتانياهو يقرأ وضع إدارة أوباما والصعوبات الجمة التي تواجهها، داخلياً وخارجياً. وبالرغم من اعتماد الدولة العبرية، في وجودها وتفوقها، على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لم يكن لدى نتنياهو من دافع للاستجابة للمطالب الامريكية بوقف كامل للاستيطان. كانت حكومة نتنياهو قد أصدرت قراراً مسبقاً باعتبار الحرم الإبراهيمي جزءاً من التراث اليهودي، بدون أصداء تذكر في العالم الإسلامي، سوى تصريح غاضب من رئيس الوزراء التركي. ثم جاء افتتاح كنيس يهودي ملاصق للمسجد الأقصى، وقرار بالتخطيط لبناء كنيس آخر في الجوار. وتلا الخطوتين الإعلان عن بناء آلاف من الوحدات السكنية في منطقة القدس، على أساس أن وعد نتنياهو المسبق للإدارة الامريكية بوقف مؤقت للاستيطان في الضفة الغربية لا يشمل بلدية القدس الكبرى. أدت سلسلة القرارات الإسرائيلية الاستفزازية إلى انفجار التظاهرات في مدينة القدس، وإلى تصاعد الغضب الفلسطيني الشعبي في فلسطين وخارجها؛ بل وإلى اندلاع احتجاجات شعبية في القاهرة واسطنبول وجاكرتا.
اختار نتنياهو، لحمقه وقصر نظره، من ناحية، ولخوفه من انهيار إئتلافه الحكومي، من ناحية أخرى، الصدام مع إدارة أوباما، بدلاً من محاولة استيعابها، معلناً عن البناء الجديد في القدس لحظة وصول نائب الرئيس الامريكي إلى الدولة العبرية في جهد جديد لإطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهنا، بدا الأمر وكأن حكومة نتنياهو لا توجه إهانة للإدارة الامريكية وحسب، بل وتعيد رسم العلاقة مع واشنطن، وكأن الدولة العبرية هي الدولة العظمى، والولايات المتحدة هي ملحقها الشرق أوسطي. مثل هذه السياسة، التي أدت في السابق إلى رد فعل بالغ العنف من وزير خارجية بوش الأب، جيمس بيكر، في محادثات التحضير لمؤتمر مدريد مع إسحق شامير، ورد فعل مشابه من بيل كلينتون تجاه نتنياهو نفسه في مباحثات واي ريفر، كان لا بد أن تولد رد فعل مناسب، حتى من إدارة أوباما الضعيفة. وبالرغم من أن الرئيس تجنب حتى الآن دخول حلبة الجدل، فقد جاء الرد الامريكي من هيلاري كلينتون، المعروفة بقربها من الموقف الإسرائيلي، ومن الجنرال باتريوس، قائد القيادة الامريكية الوسطى، المسؤولة عن الاستراتيجية الامريكية العسكرية في الفضاء الشرق أوسطي.
في لحظة واحدة اجتمعت أمام السلطة الفلسطينية جملة من التطورات الإيجابية، التي كان يفترض أن تدفعها إلى مراجعة التزامها الدوغمائي وغير المسوغ، لا سياسياً ولا أخلاقياً، بمسار تفاوضي غير موجود وبمقاربة أمنية وقمعية لعلاقاتها بشعبها. خلال العامين الاخيرين، تراجعت حظوظ الدولة العبرية في شكل غير مسبوق في دوائر الرأي العام الغربي، وفقدت الإسرائيليون كلياً تقريباً علاقة التحالف التقليدية مع تركيا. وقد جاءت الأزمة القصيرة في العلاقات الامريكية - الإسرائيلية، وحاجة إدارة أوباما المتزايدة للتفهم العربي والإسلامي لسياساته في أفغانستان وتجاه إيران، في وقت بدا وكأن الشارع الفلسطيني بات جاهزاً لخوض معركة إرادات أخرى مع حكومة نتنياهو. بانطلاق المظاهرات في القدس والخليل، ثم في نابلس، كان بإمكان السلطة الفلسطينية أن ترى اندلاع انتفاضة جديدة، على الأقل، باعتبارها عامل ضغط إضافي على حكومة نتنياهو لتحسين شروط التفاوض، أو حتى مجرد حجة لتعزيز موقف إدارة أوباما. ولكن لا عباس، المتجول أبداً خارج البلاد، ولا فياض، الملتزم أبداً سياسة القمع الأمني، يبدو على استعداد لمجرد إعادة التفكير في السياسة التي تتزايد الشواهد على فشلها ووصولها إلى نهاية الطريق. إن لم تستطع إداة أوباما، في السنوات الأولى من ولايتها، دفع المفاوضات قليلاً إلى الأمام، فمتى يمكن أن تستطيع؟
التوتر في العلاقات الامريكية - الإسرائيلية هو توتر حقيقي وجاد؛ ولكنه لن يثني الإسرائيليين عن استمرار البناء في القدس. سياسة دحر الوجود العربي والإسلامي في المدينة، وفرض أغلبية يهودية ساحقة، ليست سياسة الليكود فحسب، بل تدعمها كل الأحزاب الإسرائيلية. سيضطر نتنياهو إلى الاعتذار لإدارة أوباما عن الاستفزاز والإهانة التي وجهتها حكومته لنائب الرئيس الامريكي، ولكنه لن يتراجع عن التوسع الاستيطاني في القدس. وكانت إدارة أوباما، حتى قبل الأزمة الأخيرة، قد خفضت توقعاتها لما يمكن أن تحققه في المسار الفلسطيني للمفاوضات؛ وهو الأمر الذي جاء الخلاف مع حكومة نتنياهو ليعيد التوكيد عليه. والأرجح، أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لم يعد يحتل موقعاً متقدماً في سلم الأولويات الامريكية، اللهم إلا بمقدار ما يوفره مظهر الحرص الامريكي على استمرار المفاوضات من غطاء للسياسات الامريكية في أفغانستان وتجاه الملف النووي الإيراني.
تصاعدت الآمال الفلسطينية والعربية بعودة الحياة إلى مسار المفاوضات حتى قبل أن يفوز أوباما في انتخابات الرئاسة الامريكية. كان مسار أنابوليس قد أصيب بموت سريري منذ الشهور الأخيرة لإدارة بوش الابن؛ وفي ظل انهيار وضع بوش الداخلي وانحياز أركان إدارته المعروف للموقف الإسرائيلي، وترنح حكومة أولمرت، لم يعد هناك من أمل بإحراز أي تقدم يذكر، ولا حتى في استمرار المفاوضات من أجل المفاوضات. المشكلة، أن حكومة السلطة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس عباس وظله الجديد سلام فياض، كانت قد حسمت موقفها بالتزام خيار التفاوض، وطرح كل الخيارات الأخرى جانباً، بغض النظر عن أية اعتبارات سياسية أو استراتيجية. وبذلك، أصبح فوز أوباما أملاً منشوداً لعباس ورئيس حكومته والأنظمة العربية القليلة المتبنية له. وليس ثمة شك أن المؤشرات التي أطلقها أوباما، سراً وعلناً، كانت مختلفة عن المعهود، أو على الأقل عن الرئيس السابق له. لم يكن هناك ما يوحي بقدوم إدارة تقف خلف الحقوق الفلسطينية، بالطبع، ولكن ما رشح كان كافياً لإعطاء انطباع بجدية المرشح الديمقراطي للتعامل مع ملف المفاوضات، وحرصه على وضع نهاية لسياسة المعسكرات الفاصلة والقطعية التي اتبعتها إدارة سلفه، وأطلقت موجات من الحرب والعنف وعدم الاستقرار في المشرق، من ناحية، وانتهت وبالاً على وضع الولايات المتحدة العالمي، من ناحية أخرى. وفي التحضير لتولي أوباما مقاليد الحكم، تسارعت عجلة القمع الأمني في الضفة الغربية لكل من يشتبه بميول مقاومة، ووضعت القاهرة ثقلها كله خلف مشروع المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
أطلقت إدارة أوباما حملة كبرى من العلاقات العامة، الموجهة أصلاً وفي دائرتها الأكبر للراي العام العربي والإسلامي، من خطابي أنقره واسطنبول إلى خطاب جامعة القاهرة. وفي موازاة حملة العلاقات العامة، كلف الرئيس الجديد واحداً من أبرز السياسيين الامريكيين المخضرمين، جورج ميتشل، بتعهد ملف مفاوضات السلام العربية - الإسرائيلية، ومسارها الفلسطيني على وجه الخصوص. لم يكن سجل ميتشل يتضمن نجاحه الكبير في وضع نهاية للنزاع في إيرلندا الشمالية وحسب، بل أيضاً قيامه بدور كبير في الملف الفلسطيني في خضم الانتفاضة الفلسطينية الثانية خلال ولاية بوش الأولى. وبخلاف الشائع، كانت إدارة أوباما، وليس حكومة عباس، هي من وضع إيقاف الاستيطان شرطاً لانطلاق المفاوضات. والواضح أن ميتشل، الذي كان لاحظ خطورة استمرار التوسع الاستيطاني اليهودي على مشروع إقامة دولة فلسطينية، منذ تمثيله لإدارة بوش في جهود السلام، لعب دوراً أساسياً في إعادة مسألة الاستيطان إلى قلب عملية السلام.
بيد أن لا أوباما، ولا السلطة الفلسطينية، ولا الدول العربية، كان بإمكانها فرض إيقاف الاستيطان، ولا حتى الإيقاف المؤقت، على حكومة إسرائيلية يقودها نتنياهو في تحالف مع أمثال ليبرمان. والطرف الأساسي هنا هو إدارة أوباما. فقد أمضى الرئيس الامريكي الجديد عامه الأول في انشغال يومي لمحاولة تمرير خطته الخاصة بإصلاح النظام الصحي للولايات المتحدة، الخطة التي احتلت الموقع الأول والأبرز في برنامجه الانتخابي. يعرف أوباما أنه بدون تحقيق وعوده في هذا المجال، فسيحكم على إدارته بالفشل، حتى قبل أن يقترب موعد الانتخابات الرئاسية. وبدون تعزيز وضعه الداخلي، لا يستطيع رئيس أمريكي، مهما بلغ من براعة، أن يتعهد مبادرات ذات وزن على صعيد السياسة الخارجية. ولكن حتى على صعيد أولويات السياسة الخارجية، كما الحرب في أفغانستان والملف النووي الإيراني، كانت خطوات إدارة أوباما تواجه عقبات جمة، لم تكن في حسابات الرئيس ومعاونيه الكبار. في أفغانستان، اضطرت الإدارة، أولاً، إلى تقبل بتزييف الانتخابات وبقاء كرزاي في منصبه، بدون أن تكون على قناعة بجدوى وجوده في منصب الرئاسة؛ بينما كانت طالبان تحرز تقدماً وراء الآخر، ولم يعد في جعبة الإدارة سوى القفز في الهواء وزيادة عدد القوات الامريكية في شكل ملموس، بدون أن تعرف على وجه اليقين ما يمكن أن ينجم عن مثل هذه الخطوة. أما على صعيد الملف النووي الإيراني، فقد وقفت إدارة أوباما، ولم تزل، حائرة بين اعتماد سياسة الضربة العسكرية، وتحمل عواقبها غير المحسوبة وغير القابلة للتوقع، أو الاكتفاء بفرض عقوبات جديدة، لم يعد واضحاً، في ظل الإحجام الصيني والتلاعب الروسي، فعاليتها أو المدى الذي يمكن أن تصل إليه.
كما غيره في العالم، كان نتانياهو يقرأ وضع إدارة أوباما والصعوبات الجمة التي تواجهها، داخلياً وخارجياً. وبالرغم من اعتماد الدولة العبرية، في وجودها وتفوقها، على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لم يكن لدى نتنياهو من دافع للاستجابة للمطالب الامريكية بوقف كامل للاستيطان. كانت حكومة نتنياهو قد أصدرت قراراً مسبقاً باعتبار الحرم الإبراهيمي جزءاً من التراث اليهودي، بدون أصداء تذكر في العالم الإسلامي، سوى تصريح غاضب من رئيس الوزراء التركي. ثم جاء افتتاح كنيس يهودي ملاصق للمسجد الأقصى، وقرار بالتخطيط لبناء كنيس آخر في الجوار. وتلا الخطوتين الإعلان عن بناء آلاف من الوحدات السكنية في منطقة القدس، على أساس أن وعد نتنياهو المسبق للإدارة الامريكية بوقف مؤقت للاستيطان في الضفة الغربية لا يشمل بلدية القدس الكبرى. أدت سلسلة القرارات الإسرائيلية الاستفزازية إلى انفجار التظاهرات في مدينة القدس، وإلى تصاعد الغضب الفلسطيني الشعبي في فلسطين وخارجها؛ بل وإلى اندلاع احتجاجات شعبية في القاهرة واسطنبول وجاكرتا.
اختار نتنياهو، لحمقه وقصر نظره، من ناحية، ولخوفه من انهيار إئتلافه الحكومي، من ناحية أخرى، الصدام مع إدارة أوباما، بدلاً من محاولة استيعابها، معلناً عن البناء الجديد في القدس لحظة وصول نائب الرئيس الامريكي إلى الدولة العبرية في جهد جديد لإطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهنا، بدا الأمر وكأن حكومة نتنياهو لا توجه إهانة للإدارة الامريكية وحسب، بل وتعيد رسم العلاقة مع واشنطن، وكأن الدولة العبرية هي الدولة العظمى، والولايات المتحدة هي ملحقها الشرق أوسطي. مثل هذه السياسة، التي أدت في السابق إلى رد فعل بالغ العنف من وزير خارجية بوش الأب، جيمس بيكر، في محادثات التحضير لمؤتمر مدريد مع إسحق شامير، ورد فعل مشابه من بيل كلينتون تجاه نتنياهو نفسه في مباحثات واي ريفر، كان لا بد أن تولد رد فعل مناسب، حتى من إدارة أوباما الضعيفة. وبالرغم من أن الرئيس تجنب حتى الآن دخول حلبة الجدل، فقد جاء الرد الامريكي من هيلاري كلينتون، المعروفة بقربها من الموقف الإسرائيلي، ومن الجنرال باتريوس، قائد القيادة الامريكية الوسطى، المسؤولة عن الاستراتيجية الامريكية العسكرية في الفضاء الشرق أوسطي.
في لحظة واحدة اجتمعت أمام السلطة الفلسطينية جملة من التطورات الإيجابية، التي كان يفترض أن تدفعها إلى مراجعة التزامها الدوغمائي وغير المسوغ، لا سياسياً ولا أخلاقياً، بمسار تفاوضي غير موجود وبمقاربة أمنية وقمعية لعلاقاتها بشعبها. خلال العامين الاخيرين، تراجعت حظوظ الدولة العبرية في شكل غير مسبوق في دوائر الرأي العام الغربي، وفقدت الإسرائيليون كلياً تقريباً علاقة التحالف التقليدية مع تركيا. وقد جاءت الأزمة القصيرة في العلاقات الامريكية - الإسرائيلية، وحاجة إدارة أوباما المتزايدة للتفهم العربي والإسلامي لسياساته في أفغانستان وتجاه إيران، في وقت بدا وكأن الشارع الفلسطيني بات جاهزاً لخوض معركة إرادات أخرى مع حكومة نتنياهو. بانطلاق المظاهرات في القدس والخليل، ثم في نابلس، كان بإمكان السلطة الفلسطينية أن ترى اندلاع انتفاضة جديدة، على الأقل، باعتبارها عامل ضغط إضافي على حكومة نتنياهو لتحسين شروط التفاوض، أو حتى مجرد حجة لتعزيز موقف إدارة أوباما. ولكن لا عباس، المتجول أبداً خارج البلاد، ولا فياض، الملتزم أبداً سياسة القمع الأمني، يبدو على استعداد لمجرد إعادة التفكير في السياسة التي تتزايد الشواهد على فشلها ووصولها إلى نهاية الطريق. إن لم تستطع إداة أوباما، في السنوات الأولى من ولايتها، دفع المفاوضات قليلاً إلى الأمام، فمتى يمكن أن تستطيع؟
التوتر في العلاقات الامريكية - الإسرائيلية هو توتر حقيقي وجاد؛ ولكنه لن يثني الإسرائيليين عن استمرار البناء في القدس. سياسة دحر الوجود العربي والإسلامي في المدينة، وفرض أغلبية يهودية ساحقة، ليست سياسة الليكود فحسب، بل تدعمها كل الأحزاب الإسرائيلية. سيضطر نتنياهو إلى الاعتذار لإدارة أوباما عن الاستفزاز والإهانة التي وجهتها حكومته لنائب الرئيس الامريكي، ولكنه لن يتراجع عن التوسع الاستيطاني في القدس. وكانت إدارة أوباما، حتى قبل الأزمة الأخيرة، قد خفضت توقعاتها لما يمكن أن تحققه في المسار الفلسطيني للمفاوضات؛ وهو الأمر الذي جاء الخلاف مع حكومة نتنياهو ليعيد التوكيد عليه. والأرجح، أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لم يعد يحتل موقعاً متقدماً في سلم الأولويات الامريكية، اللهم إلا بمقدار ما يوفره مظهر الحرص الامريكي على استمرار المفاوضات من غطاء للسياسات الامريكية في أفغانستان وتجاه الملف النووي الإيراني.

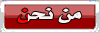






» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918